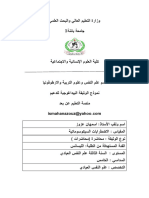Professional Documents
Culture Documents
الحالات البينية الحدية
الحالات البينية الحدية
Uploaded by
ghazalimokhtaria360 ratings0% found this document useful (0 votes)
35 views5 pagesOriginal Title
الحالات-البينية-الحدية
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
35 views5 pagesالحالات البينية الحدية
الحالات البينية الحدية
Uploaded by
ghazalimokhtaria36Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 5
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
جامعة مصطفى اسطمبويل معسكر
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم النفس وعلوم التربية
المقياس :علم النفس المرضي
الحصة :رقم 11التاريخ 7474/40/72
عنوان المحاضرة :الحاالت البينية (الحدية) )(états limite
د.بوزار يوسف
أستاذ مساعد"ب"
youcef.bouzar@univ-mascara.dz
مدخل إلى الحاالت الحدية ):(les états limites
تعتبر الحاالت الحدية أو البينية مركز تتجمع حوله كل اإلختالالت ذات البناء النفسي غير المنتظم وغير
المتماسك ،فهو مصطلح يتناسب جيدا مع مفهوم "الحيز البيني" ) (aire intermédiaireأو االنتقالي
) (transitionnelleالذي اقتراحه وينيكوت ) ،(Winnicottلهذا تعتبر أفكار وينيكوت األكثر استثما ار من
قبل محللي الحاالت الحدية ،وذلك بسبب تطويره لمفهوم الموضوع االنتقالي )(objet transitionnelle
الذي له مكانة رئيسية في فهم التشكيالت الحدية ،يؤسس ذلك الموضوع حسب وينيكوت ( )1591وظائف
هامة لدى الشخص في فترة تكوينه (نموه) ،فإضافة إلى كونه مرحلة من النمو العاطفي العادي للطفل،
فإنه دفاع ضد قلق االنفصال وأيضا يعتبر كفضاء نفسي وحقل حيادي (أي ال ينتمي لعالم الطفل الداخلي
وال لعالمه الخارجي) يساعده على بناء تجربة اللعب والوهم الذي يكتشف فيها المنطقة والمساحة الوسيطة
بين عالمه الداخلي الخاص والعالم الخارجي المشترك ،وهي التي تسمح له بتعويض جدلية الحضور
والغياب للموضوع األمومي.
عدة أشكال يضمها القطب البيني (الحاالت الحدية) هو األشكال الجسدية )(Psychosomatique
هناك ّ
واالنحرافية (االنحرافات) ) )Perversionحاالت اإلدمان ) ،(Toxicomaneوفي هذه المحاضرة سوف
يتم عرض نماذج عن الحاالت الحدية (البينية).
-1الحاالت الحدية (البينية):
تعرف الحاالت الحدية من الناحية التصنيفية والبنيوية كوسيط بين البنية العصابية والبنية الذهانية.
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
جامعة مصطفى اسطمبويل معسكر
تحدد هذا المفهوم من خالل األعمال على بنية الشخصية ،وذلك مع أعمال Kernbergو Kohutفي
الواليات المتحدة ،وأعمال Bergeretفي فرنسا .حيث وجد هؤالء الباحثون صعوبات للقيام بعالج
تحليلي مع بعض المفحوصين ،حيث يظهر هؤالء عدم أمن داخلي كبير ،وعدم تحمل لإلحباط ،وحساسية
شديدة إزاء المالحظات .وهم يظهرون نكوصا غير متعود عليه في التحويل ،كل هذا يجعل المحلل
النفساني يغير أو يعدل اإلجراء العالجي.
عرض ب.بروسي تطور األعمال حول الحاالت الحدية وانتهى إلى أن أهم ما يميز التوظيف الحدي
هو مرض السريرة والتوظيف بالمظهر ،ويقصد بمرض السريرة ضعف استثمار الفضاء النفسي الداخلي
الذي يتجلى في مظاهر مثل :العجز عن البقاء وحيدا ،التبعية ،الشراهة اإلدمانية ،االندفاعية واالنتقال إلى
الفعل (المرور إلى الفعل) ) ،(le passage a l’acteعالقة الموضوع االعتمادية ،حاجة األنا إلى
السند ،أو حاجة التوظيف النفسي إلى ذلك اعتمادا على توظيف اآلخر .وغالبا ما يلجأ الشخص في هذه
الحاالت إلى التوظيف المظهري تحت غطاء القطاع التكيفي بذات مزيفة كي يسقط نشاطا هواميا فجا
(عنيفا) ذي طابع قبل تناسلي يكثف فيه المراحل الفمية والشرجية والتناسلية المبكرة ،أو متمركز حول
مشهد بدائي مرعب مع بروزات نزوية مباشرة و قوية.
ويصر المحللون كثي ار على النزعة النزوية التدميرية التي تسوي استمرار االرتباط بالموضوع وفق
صيغة يقترحها بروسي على الشكل التالي :غياب الموضوع = فقدان الموضوع = تخريب الموضوع =
تأنيب = إصالح أو انهيار ،لذلك يخلص بروسي إلى أن ما يؤسس إشكالية التنظيم النفسي الحدي يتمثل
من جهة في الطابع الالاندماجي لالزدواج النزوي الذي يجعل إرصان الحداد األصلي للموضوع أم ار
مستحيال ،وكذا الضيق األولي أو حتى اإلخصاء األولي ،مما يفسح المجال آلليات دفاعية متقهقرة:
كالنفي ،واالنشطار ،واإلسقاط ،والمثلنة البدائية ،والتقمص اإلسقاطي ،من جهة أخرى فشل تشكيل الجنسية
التناسلية والبناء األوديبي لالختالف بين الجنسين وبين األجيال ،وذلك ما يجعل العالقات بالمواضيع
وبالذات كتهديد نرجسي ال يطاق.
-2األشكال االنحرافية):(Les Formes Perverses
تناقش ف.نو ( )4002عالقة االنحراف بالتوظيف الحدي لتطرح إشكالية اعتبار االنحراف كسياق
سيكومرضي متعدد األشكال ،خاصة إذا علمنا أن فرويد جعله من جهة كتشكيل سوي لدى الطفل ناجم
عن االستعداد الفطري ،ومن جهة أخرى اعتبره كوجه خفي للعصاب ،ألن هذا األخير يمثل صورته
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
جامعة مصطفى اسطمبويل معسكر
السلبية ،بحيث "تتشكل األعراض العصابية جزئيا حسب تعبير فرويد ،على حساب جنسية ال سوية،
وبذلك يمكننا القول أن العصاب هو نقيض (صورة سلبية) لالنحراف".
تذكر ف.نو أن مفهوم التنظيم االنحرافي قد اختفى لدى العديد من الكتّاب لصالح التنظيمات الحدية
ومفهوم اإلعدادات االنحرافية .تمثل هذه األخيرة عند بارجوري أحد الفرعين الذي يسمح بتطور الحاالت
الحدية ،بحيث يشكل اإلعداد الطباعي الفرع الثاني.
وقد حدد فرويد المعايير التي تدخل الراشد في االنحراف تتمثل في:
-تجاوز الحاجز القائم بين األجناس (توجيه النزوة الجنسية إلى الحيوانات مثال).
-انتهاك الحاجز القائم على مانع المحارم (قرب المحارم).
-انتهاك الحاجز الموجود بين األشخاص من نفس الجنس (اإلشباع الجنسي المثلي).
-تحويل الدور التناسلي إلى أعضاء و مساحات جسدية أخرى (المازوشية ،التيمية وغيرها).
-3األشكال الجسدية ):(Les Formes Somatiques
تطرح هذه األشكال مسألة تصنيفها ضمن التنظيمات الحدية أو انتمائها إلى االضطرابات السيكو
جسدية ،ألن األعراض الجسدية لها مكانتها في التوظيف النفسي لدى فئة األشخاص المصابين بهذا النوع
من االضطرابات.
تتأكد صعوبة إدراج هذه األشكال ضمن التنظيمات الحدية خاصة إذا علمنا إصرار أصحاب المدرسة
السيكو جسدية الحديثة في باريس وعلى رأسهم ب.مارتي ) (P. Martyعلى استقالل الحقل
السيكوسوماتي في تناوله لطرق التنظيم النفسي ،إذ يقترحون تصنيفا مرضيا جديدا يضم كل التوظيفات
النفسية الممكنة ،وال يقتصر فقط على األشخاص الذين يستشيرون الطب العقلي أو التحليل النفسي،
وتقصد بهم ر.دوبراي مجموعة األفراد الذين ُيستقبلون في الهياكل الصحية "العادية" من أجل اختالالت
جسدية عابرة أو مزمنة.
تحدث غرين عن مصطلح "عته الجسد" ليعني به عجز الجسد عن احتواء االختالالت السيكو جسدية
خالل النكوصات السيكو جسدية ،وقد يوافق ذلك عدم الكفاءة في االقتصاد السيكوسوماتي لدى مارتي،
باعتبار أن الجسد يستمد قوته من مكسبه في التعقيل ،أي من اقتصاده السيكو جسدي الذي تطور عبر
النمو.
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
جامعة مصطفى اسطمبويل معسكر
تميل بعض التناوالت التحليلية إلى تقريب العصابات الراهنة التي تحدث عنها فرويد من التصنيف
السيكوسوماتي ،معتبرين إياها من العصابات سيئة التعقيل ،نظ ار النتقال الطاقة النزوية مباشرة من النفس
إلى الوظائف الجسدية دون وساطة رمزية ،أي دون عمل للتعقيل الذي يميز عصابات الدفاع.
لكنه من المهم معرفة نظرة المنظور السيكوسوماتي التي ال تتوقف عند هذا التناول الذي يبدو بسيطا،
فقد انتهى رأي ر.دوبراي ( )4009إلى أن "كل ما يمس الجسد وليس له طابع تحول هستيري يدخل في
إطار ما سميته التعبير الجسدي ،يتراوح هذا األخير من العرض المألوف جدا إلى اإلصابات الجسدية
األشد خطورة .ليس للتعبير الجسدي ،مهما تكن طبيعته أو شكله أو شدته ،معنى بالمفهوم التحليلي ،أي
أن االضطراب الجسدي ال يمكن أن يزول بزوال الكبت ،ألن هذا األخير غير موجود مثلما نجده في
نموذج التحول الهستيري".
وبذلك تخلص دوبراي إلى أن التعبير الجسدي ،مثله مثل األعراض العقلية اإليجابية ،يمكن اعتباره
ثراء عوض أن يكون هشاشة .ألنه في حالة تراكم وفيض االقتصاد السيكو جسدي ،تكون اإلجابة
بالتجسيد عابرة ،في حين يتطلب العمل النفسي وقتا غير محدود لإلرصان ،وبذلك يمكن أن يشجع
التجسيد العابر والمفاجئ على التوقف في نقاط التثبيت-النكوص من أجل إعداد فترة متدرجة بعد ذلك
إلعادة التنظيم ،وبالتالي المساهمة في المحافظة على الحياة.
يمكن تلخيص بعض الخصائص التي تميز الشخصيات الجسدية في النقاط التالية:
-عدم استقرار التوظيف النفسي في بنية محددة نظ ار لغياب نقاط التثبيت عند مرحلة محددة من النمو
النفسي ،بسبب صعوبات اإلدخال واالحتفاظ بالمواضيع.
-في حالة فشل الدفاعات الطبعية في حد ذاتها نظ ار لضعفها ،تلجأ بعض الشخصيات الجسدية إلى
التصرفات العملية الواقعية ،وهي محدودة في التكيف اآللي (أي في عمل وحركة مستمرة) ،لذلك فهي
أكثر عرضة من غيرها لالختالالت الجسدية ،كما نجد لدى هذه الفئة فقر في العالقات العاطفية والجنسية
وفقر في االتصاالت التي يطبعها الحياد.
-أسئلة عن المحاضرة:
-ماذا يقصد وينيكوت ) (Winnicottبمفهوم الموضوع االنتقالي )(objet transitionnelle؟.
-أبحث عن اضطرابات أخرى صنفت ضمن األشكال الحدية (الحاالت الحدية)؟.
-حدد أهم اآلليات (الميكانيزمات) الدفاعية التي نجدها في التنظيم الحدي؟.
-مراجع للمساعدة:
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
جامعة مصطفى اسطمبويل معسكر
-معتصم ميموني بدرة .)4009( .االضطرابات النفسية والعقلية عند الطفل والمراهق ،الجزائر :ديوان
المطبوعات الجامعية.
-البالنش وبونتاليس .)1599( .معجم مصطلحات التحليل النفسي (ترجمة :حجازي مصطفى) ،الجزائر.
-سي موسي عبد الرحمان ،بن خليفة محمود .)4010( .علم النفس المرضي التحليلي واإلسقاطي،
الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية.
-Ajuriaguerra,(1978). Manuel de Psychiatrie de l’enfant, Masson.
- Winnicott, D (1958). La capacité d’être seul, in de la pédiatrie à la
psychanalyse, paris, payot.
You might also like
- ليسانس2-علم النفس المرضي-د.بن دربال مليكةDocument13 pagesليسانس2-علم النفس المرضي-د.بن دربال مليكةMOk RaneNo ratings yet
- نظرية بيار مارتيDocument25 pagesنظرية بيار مارتيkharif.nourelhouda02No ratings yet
- Article 04-1Document10 pagesArticle 04-1Salma SaghiriNo ratings yet
- وزارة التعليم العالي والبحث العلميDocument3 pagesوزارة التعليم العالي والبحث العلميAbdelhamid BouferroukNo ratings yet
- المحاضرة الرابعة البنية علم النفس المرضيDocument4 pagesالمحاضرة الرابعة البنية علم النفس المرضيasmaarezki229No ratings yet
- المــنهج العيــاديDocument6 pagesالمــنهج العيــاديmaminepitchoNo ratings yet
- 1739-Article Text-4559-1-10-20200225Document28 pages1739-Article Text-4559-1-10-20200225Muhamad MansurNo ratings yet
- البنيات النفسمرضيةDocument4 pagesالبنيات النفسمرضيةعبداللطيف الحسوسةNo ratings yet
- البنيات النفسمرضيةDocument4 pagesالبنيات النفسمرضيةعبداللطيف الحسوسة100% (1)
- المدرسةالسيكوسوماتيةDocument25 pagesالمدرسةالسيكوسوماتيةsouhila47metliliNo ratings yet
- تمهيدDocument5 pagesتمهيدYAHIAOUI Leila KaoutherNo ratings yet
- المحاضرة 5 ماستر 1 2021Document19 pagesالمحاضرة 5 ماستر 1 2021Bousselaoui RababNo ratings yet
- SO409 النظريات السوسيولوجية المعاصرة1Document10 pagesSO409 النظريات السوسيولوجية المعاصرة1Mohammedi AbdennourNo ratings yet
- محاضرات في مقياس ابستمولوجيا العلوم الاجتماعية3Document4 pagesمحاضرات في مقياس ابستمولوجيا العلوم الاجتماعية3Hakim VitchNo ratings yet
- Cours Psy Enf Ado PDFDocument43 pagesCours Psy Enf Ado PDFInes GhamriNo ratings yet
- محاضرات في مقياس ابستمولوجيا العلوم الاجتماعية3Document10 pagesمحاضرات في مقياس ابستمولوجيا العلوم الاجتماعية3Mouhaymin MouhaNo ratings yet
- تصور الذات لدى المراهق ضحية التنمر المدرسيDocument18 pagesتصور الذات لدى المراهق ضحية التنمر المدرسيkadiahlembasmaNo ratings yet
- (العلاج ذو المنحى التحليل (أ. كريمة طوطاويDocument17 pages(العلاج ذو المنحى التحليل (أ. كريمة طوطاويkharif.nourelhouda02No ratings yet
- العلاجات النفسية ذات المنحى التحليليDocument62 pagesالعلاجات النفسية ذات المنحى التحليليimadNo ratings yet
- طلبة ام لخيوط بورزق تفهم الموضوعDocument13 pagesطلبة ام لخيوط بورزق تفهم الموضوعsarahminal62No ratings yet
- مطبوعة أطر مصححة - mergedDocument112 pagesمطبوعة أطر مصححة - mergedZENITH PNLNo ratings yet
- Eysenck Personality Questionnaire) EPQ (Document101 pagesEysenck Personality Questionnaire) EPQ (moheyaldeenyuosefNo ratings yet
- مفهوم السيمائيةDocument22 pagesمفهوم السيمائيةHair StylesNo ratings yet
- المحاضرة الاولىDocument5 pagesالمحاضرة الاولىmazen332332No ratings yet
- السيكوسوماتيك العلائقيةDocument4 pagesالسيكوسوماتيك العلائقيةNourEmmyNo ratings yet
- المحاضرة الثانيةDocument8 pagesالمحاضرة الثانيةAllioui SalahNo ratings yet
- تموذج 9 موضوع 2 جDocument11 pagesتموذج 9 موضوع 2 جSamar MNo ratings yet
- محاضرات في الاضطرابات السيكوسوماتيةDocument26 pagesمحاضرات في الاضطرابات السيكوسوماتيةSaci MeriemNo ratings yet
- The Tasks of The Psychologist and The Difficulties He Faces in Performing His ProfessionDocument13 pagesThe Tasks of The Psychologist and The Difficulties He Faces in Performing His Professionlilololita49No ratings yet
- مراجعةDocument7 pagesمراجعةÏk Rãm BenkaciNo ratings yet
- UntitledDocument20 pagesUntitledNoury BelNo ratings yet
- محاضرات نظريات الشخصيةDocument16 pagesمحاضرات نظريات الشخصيةAyöü AyaNo ratings yet
- تابع نظريات الارشاد و التوجيهDocument3 pagesتابع نظريات الارشاد و التوجيهzinouhafaidia3No ratings yet
- أكتشف شخصيتك وشخصية الآخرين كيرو لويسDocument229 pagesأكتشف شخصيتك وشخصية الآخرين كيرو لويسSamirsameerNo ratings yet
- أكتشف شخصيتك وشخصية الآخرين كيرو لويسDocument229 pagesأكتشف شخصيتك وشخصية الآخرين كيرو لويسHaidar Hero100% (1)
- نظريات أساسية في التوجيه والإرشادDocument7 pagesنظريات أساسية في التوجيه والإرشادTyrano SorasNo ratings yet
- اكتشف شخصيتكDocument229 pagesاكتشف شخصيتكSuhailAlakhliNo ratings yet
- أكتشف شخصيتك وشخصية الآخرين كيرو لويسDocument229 pagesأكتشف شخصيتك وشخصية الآخرين كيرو لويسMohammed SharafNo ratings yet
- بحث حول مرض الفصام الشيزوفرينيا - 2Document23 pagesبحث حول مرض الفصام الشيزوفرينيا - 2Hind HindNo ratings yet
- انطباق الفكر مع نفسهDocument6 pagesانطباق الفكر مع نفسهAminø MohNo ratings yet
- الهروب من الإيديولوجيا - بدر باسعدDocument14 pagesالهروب من الإيديولوجيا - بدر باسعدAssem Ashraf KhidhrNo ratings yet
- محاضرات علم النفس المرضيDocument30 pagesمحاضرات علم النفس المرضيkhoulihind05No ratings yet
- اليات الدفاعDocument12 pagesاليات الدفاعisra.2002hfNo ratings yet
- توطئة في علم النفسDocument6 pagesتوطئة في علم النفسMeriame LaazizNo ratings yet
- التحليل النفسي والعلاجات السيكو دينامية بين النظرية والممارسة Psychoanalysis and Psychodynamic Psychotherapies Between Theory and PracticeDocument16 pagesالتحليل النفسي والعلاجات السيكو دينامية بين النظرية والممارسة Psychoanalysis and Psychodynamic Psychotherapies Between Theory and Practicelamosh2000.99No ratings yet
- آليات الدفاعDocument9 pagesآليات الدفاعقادم من هناكNo ratings yet
- طالبة سبسوب لمحة تاريخيةDocument15 pagesطالبة سبسوب لمحة تاريخيةAb AbdelmalikNo ratings yet
- مفاهيم النمو ونظرياتهDocument15 pagesمفاهيم النمو ونظرياتهEl ghiate Ibtissame100% (1)
- PDF 181Document102 pagesPDF 181yasminearamisNo ratings yet
- علم النفس الفسيولوجيDocument64 pagesعلم النفس الفسيولوجيImen ArabNo ratings yet
- المحاضرة الاوليDocument6 pagesالمحاضرة الاوليaicha aichaNo ratings yet
- Psychologie 1Document20 pagesPsychologie 1m2zcopieNo ratings yet
- المحاضرة2Document3 pagesالمحاضرة2Sohib DzNo ratings yet
- بحث عن ميادين علم النفسDocument8 pagesبحث عن ميادين علم النفسعلم النفسNo ratings yet
- علم النفس الفسيولوجيDocument177 pagesعلم النفس الفسيولوجيnouhaylagaraoun22No ratings yet
- - علم النفس هواري 2024Document4 pages- علم النفس هواري 2024saferbouchra82075% (4)
- أسباب التعصب الفكري والسلوكيDocument15 pagesأسباب التعصب الفكري والسلوكيMustafa100% (2)
- - - علم النفس هواري 2024 -Document4 pages- - علم النفس هواري 2024 -midoplays71No ratings yet