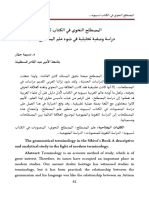Professional Documents
Culture Documents
المعنى بين التصريح والتضمين عند علماء الأصول
المعنى بين التصريح والتضمين عند علماء الأصول
Uploaded by
btissambouafifCopyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
المعنى بين التصريح والتضمين عند علماء الأصول
المعنى بين التصريح والتضمين عند علماء الأصول
Uploaded by
btissambouafifCopyright:
Available Formats
ص ص 265-247 ّ
المجلد /13 :العدد( 02 :ماي . )2022 الممارسات ّالل ّ
غوية
أ
المعنى بين التصريح والتضمين عند علماء الصول
أ
محمد المين قادري ،د .فتيحة بلغدوش
أ
1المدرسة العليا للساتذة ببوزريعة (الجزائر)aminekadriyacine@gmail.com ،
أ
2المدرسة العليا للساتذة ببوزريعة (الجزائر)fatibelge@yahoo.com ،
النشر2022/05/30 : القبول2022/05/20: اإلرسال2021/10/03 :
الملخص:
أ ُت ُّ
عد جدلية المعنى قضية جوهرية عند الصوليين ،فالختلف في طرق إدراك المعنى هو
أ
اختلف في الحكام الشرعية ،فلقد اعتمد التجاه الظاهري على المعنى الحرفي للنص ،وفي
هذا مقاربة لسانية للمدارس الشكلية الصورية التي تجعل النص منغلقا على نفسه ،كما اعتمد
التجاه المقاصدي على قصدية الخطاب لتحقيق مصالح ّالناس ،وفي هذا مقاربة لسانية تداولية
تتجاوز الوضع اللغوي لتبحث في مجال الستعمال اللغوي الذي يعنى بالمكونات اللغوية وغير
اللغوية إلدراك المعنى المراد.
أ
الکلمات المفاتيح:المقاصد؛ التصريح؛ التضمين؛ دللة القول؛ التاويل.
The Meaning between Explicitness and Implicitness
from the Viewpoint of Muslim Jurisprudents
Abstract:
ّ
المؤلف المرسل
EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583 247
265-247 ص ص ّ
. )2022 (ماي02 : العدد/13 :المجلد ّ الممارسات ّالل
غوية
The argument about the meaning issues was at the heart of the debate
among given that diversity in the tools to reach meaning leads necessarily to
diversity in verdicts arising out of them. Advocates of explicitness resorted to
the literal meaning of texts, resembling the formal/structural linguistic
schools which take texts as self-contained. Meanwhile, advocates of the
intentionality sought to uncover the intended meaning of texts in an attempt
to consider people’s interests, which is considered as a linguistic pragmatic
approach. This latter went beyond the linguistics proper towards language use
and utilized both linguistic and non-linguistic components to reach the
intended meaning.
Key words:intentions; explicitness;implicitness;speech’s meaning;
interpretation.
:مقدمة
أ أ
وشرح الحاديث النبوية الشريفة وبذلوا،لقد عك ف علماء الصول على تفاسير القران
أ ّ ،مجهودات متمايزة في محاولة الوصول إلى المعنى
لكن الذي لفت انتباه الدراسيين ان تفسير
أ
النصوص الشرعية ابان على وجود اتجاهات مختلفة في فهم المعنى الذي ترمي إليه النصوص
التجاه الظاهري والتجاه: ويمكن تمييزها بصفة عامة إلى اتجاهين رئيسيين هما،الديني ة
أ
ويجعل المعاني الصريحة، فالتجاه الظاهري يقف عند الفاظ النصوص وحرفيتها،المقاصدي
أ أ
اما التجاه المقاصدي فل يقف عند ظاهر اللفظ في الوصول،المرتبطة بظاهر اللفظ هي الصل
أ
وقد جاء هذا البحث من اجل محاولة، بل يستند إلى مقصد الشريعة ِوحكمتها،إلى المعنى
أ أ
فما مدى حجية كل اتجاه،إماطة اللثام عن ابرز طرق الوصول إلى المعنى عند علماء الصول
في العتماد على الطريقة المتبعة لبلوغ المعنى؟ وما هي العلقة الممكنة بين المعاني
. والمعاني الضمنية؟،الصريحة
EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583 248
ص ص 265-247 ّ
المجلد /13 :العدد( 02 :ماي . )2022 الممارسات ّالل ّ
غوية
وتسوقنا هذه اإلشكالية إلى مجموعة من الفرضيات هي:
أ
-هناك مجال واسع من المعاني المشتركة التي ترتكز على الدلة القطعية ،وليقع الختلف إل
فيما هو ظني الدللة.
أ
-المعاني الصريحة والمعاني الضمنية تمثل اختلفا مشروعا وسعة في المر ما دامت تستند إلى
دليل.
والغاية من هذا البحث هي استظهار مقاربة بين بعض النظريات اللسانية الحديثة
أ
وبعض الراء الصولية في رحلة البحث عن المعنى ،مما يستدعي تطبيق منهجية تتنوع بين
المنهج التداولي ،والمنهج الوصفي التحليلي ،فالوقوف على المعاني الصريحة والمعاني
الضمنية يتناسب مع استخدام اليات تداولية ،وتحليل وصفي يعتمد على الشرح والتفسير.
ول :التجاه الظاهري والمعنى الصريح: أا ً
أ أ أ
يتميز التجاه الظاهري بالخذ بظواهر النصوص عند استنباط الحكام ،والمر يقتضي
والفور ()1 أ
" الوجوب كما يقتضي الفور "فالعمل في اوامر القران ونواهيه على الظاهر والوجوب
َ ُّ أ
شافعي المذهب ثم اتخذ يعد ابرز رواد المذهب الظاهري داود بن علي(ت 270ه)،فلقد كان و
أ
لنفسه مذهبا جديدا يعتمد على الخذ بظاهر النصوص الدينية من الك تاب والسنة ،ول يقبل
التحول عنه إل بدليل ،ومما يؤثر عن داود قوله :إن في عموميات الك تاب والسنة ما يفي بكل
جواب( )2وبعد مجيء ابن حزم(ت401ه) في القرن الخامس للهجرة انبعث المذهب الظاهري،
أ أ أ
وزاد انتشاره،ودافع ابن حزم عن اللتزام بالمعنى الظاهري رافضا كل اشكال التاويل ،فالتاويل
أ
عنده هو "نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره ،وعما وضع له في اللغة إلى معنى اخر ،فإن كان نقله
قد صح ببرهان ،وكان نقله واجب الطاعة فهو حق ،وإن كان نقله بخلف ذلك اطرح،ولم
أ ُ
إليه،وح ِكم على ذلك النقل بانه باطل"( )3ول يجوز عند الظاهرية صرف اللفظ عن ظاهره يلتفت
أ
إل بنص اخر،او إجماع ،ويستند ابن حزم في عدم جواز صرف النصوص عن موضعها في اللغة
أ أ
بقوله تعالى﴿:ويقولون سمعنا وعصينا﴾ [النساء ]46 ،وهو اقرب إلى اتباع الراي لقول عمر:
أ أ أ أ أ أ
"إياكم واصحاب الراي ،فإنهم اعداء السنن ،اعيتهم الحاديث ان يحفظوها فقالوا
EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583 249
ص ص 265-247 ّ
المجلد /13 :العدد( 02 :ماي . )2022 الممارسات ّالل ّ
غوية
أّ أ
بالراي"()4وقد جادل ابن حزم عن المعنى الظاهر جدال عنيفا والف في بيان ذلك ك تبا ورسائل
أ أ
تشرح معالم المنهج الظاهري "فاقسام الصول التي ل يعرف شيء من الشرائع إل منها،وهي
أ
اربعة :نص القران،ونص كلم رسول هللاﷺالذي إنما هو عن هللا تعالى مما صح عنه عليه
أ أ أ
السلم نقل الثقات اوالتواتر،وإجماع جميع علماء المة او دليل منها ل يحتمل إل وجها
أ أ
واحدا"( )5وفي هذا حصر لمعرفة الحكام الشرعية على اربعة سبل هي( :القران ،والسنة
أ أ أ
،واإلجماع ،والدليل) ورفض اصحاب المذهب الظاهري قضايا عديدة لجا إليها علماء الصول
أ أ
لستخلص احكام فقهية تخص ك ثيرا من المتغيرات التي واجهتهم ولم تكن في زمن اسلفهم
أ أ أ
من قبل ،فرفضوا اصل القياس لنه يعتمد على العقل ،ول يعتمد على النص،ول راي في الدين
أ أ
عندهم ويعتبرون سد الذرائع ،ومراعاة المصالح ،والستحسان هي اشد بطلنا واظهر
أ أ
عورا،حيث يقول ابن حزم" :ول يحل لحد الحكم بالراي"( )6ويدعو ابن حزم إلى ضرورة اللتزام
أ
بالظاهر وعدم مجاوزته إلى غيره ،ل ّن دين هللا ظاهر ل باطن فيه وكله برهان ،فصرف اللفظ
،واشتهر بخصومته الشديدة للذين يخالفونه من علماء عصره، عن ظاهره ممن اتبع نفسه هواها ُ
أ
فقد اعتبر من صرف الكلم عن ظاهره بدون نص من القران ،او نص من الحديث الشريف فقد
افترى على هللا ،وتجاوز حدوده "فمن ترك ظاهر اللفظ وطلب معاني ل يدل على لفظ
أ أ
الوحي،فقد افترى على هللا عز وجل( )7كما ينكر الظاهرية تعليل الحكام رغم ا ّن ابن حزم ينكر
التعليل جملة ،ويعترف ببعضه دون تسميته باسمه ،وقد وضع له الضوابط التي تنسجم مع
أ
ظاهريته وابرز هذه الضوابط:
أ أ أ
-1ل يسميها علة اوسببا حيث يقول" :حاشا التسمية بعلة اوسبب" فل يمكن ان يطلقها
أ
لنه يرفضها.
أ أ
-2ل يرى القياس – كما هو مذهبه– على تلك السباب "ولكننا انكرنا تعدي تلك الحدود
( )8 أ أ أ
إلى غيرها ووضع تلك الحكام في غير ما خصت فيه واختراع اسباب لم ياذن بها هللا
أ
وفي هذا تصريح برفض التعليل الذي يتعلق باسباب القياس.
أ
والتزام المدرسة الظاهرية بحرفية النص ياخذنا إلى مقاربة لسانية مشابهة تتمثل في
المدرسة البنيوية التي تعتمد على بنية النص في إرادة المعنى ،وعلى العناصر اللغوية في بلوغ
EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583 250
ص ص 265-247 ّ
المجلد /13 :العدد( 02 :ماي . )2022 الممارسات ّالل ّ
غوية
المعنى "فالمعنى الصريح الذي ينبثق عن البنية الصورية للقول هوما يتم إدراكه من خلل
أ
اللفظ وحده ،ويكون القول مطابقا للقصد بصورة حرفية تامة( )9فالعمل بالظاهر اصل متفق
أ عليه بين أالصوليين ،بيد أان الظاهريين أاشد تمسكا بهُ ،وت ّ
عد نماذج اخذ المعنى بظاهر
أ
الحديث الشريف ك ثيرة ،وسنذكر انموذجا على سبيل المثال ،ل على سبيل الحصر ،فقد ورد
حرمت إسبال عن النبي ﷺقوله":ما أاسفل الكعبين من اإلزار ففي ّالنار"( )10فالمدرسة الظاهرية ّ
أ أ
الثوب تحت الكعبين عمل بالمنطوق الحرفي للحديث ،ا ّما علماء المقاصد فيرون ا ّن إسبال
أ
المرء للثوب من غير خيلء ل يلحقه اإلثم ول الوعيد ،وقرينتهم في هذا ا ّن رسول هللاﷺ قال:
ّ أ أ
جر ثوبه خيلء لم ينظر هللا إليه يوم القيامة ،فقال ابو بكرّ :إن إزاري يسترخي إل ان "من ّ
أ
اتعاهده ،فقال رسول هللاﷺّ :إنك لست ّممن يفعله خيلء" فالمقصد في هذا النص هو تحريم
الخيلء والكبرياء ،فالمتثال بعدم إسبال الثوب تحت الكعبين هو امتثال طاعة وتعبد ،ول
َ
تعليل لهذا الحكم.
ً
ثانيا :المدرسة المقاصدية والمعنى المتضمن:
أ أ
قبل الخوض في السس التي ترتكز عليها المدرسة المقاصدية نحاول ان نتعرف على
مفهوم المقاصد من حيث اللغة ،ومن حيث الصطلح:
-1لغة:
أ
المقاصد ،جمع مقصد ،وتاتي في اللغة على معاني هي:
-استقامة الطريق وسهولته،فتقول قصد يقصد قصدا فهو قاصد "وطريق قاصد سهل مستقيم
()11
،وسفر قاصد سهل وقريب
-بمعنى الستواء والعتدال،فنقول قصد فلن في مشيه إذا مشى مستويا.
EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583 251
ص ص 265-247 ّ
المجلد /13 :العدد( 02 :ماي . )2022 الممارسات ّالل ّ
غوية
أ
-بمعنى العتزام والعتماد وامامة الشيء ،فيقال :قصد إليه ،وقصد له إذا اتاه وام ُه.
-2اصطالحا:
أ أ
ذهب بعض الباحثين في علم الصول انه لم يتم العثور على تعريف للمقاصد عند علماء
أ أ أ
الصول القدامى ،ا ّما عند المحدثين فمن ابرز المفاهيم التي ذكروها في تحديد ماهية المقاصد
أ
ما ذكره محمد الطاهر بن عاشور با ّن "مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة
أ أ
للشارع في جميع احوال التشريع اومعظمها،بحيث ل تختص ملحظتها بالكون في نوع خاص
أ
من احكام الشريعة( )12ويضيف لهذا المفهوم المجالت التي تستهدفها المقاصد "فيدخل في
أ
هذا اوصاف الشريعة ،وغايتها العامة ،والمعاني التي ل يخلو التشريع من ملحظتها ،ويدخل
أ أ أ أ
في هذا ايضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر انواع الحكام"( )13وهذا يعني انهم يقفون
عند الحكمة من الحكم الشرعي لك ثير من المسائل.
أ أ
ويتفق اغلب الدراسيين ان الذي ابتدع علم المقاصد هو الشاطبي(ت790ه) وقد جاء
أ
في حقه الك ثير من الشهادات "فقد بقي علم الصول فاقدا ِقسما عظيما هو شطر هذا العلم
أ أ أ
الباحث عن احد ركنيه حتى هيا هللا سبحانه وتعالى ابا إسحاق الشاطبي في القرن الثامن
أ
الهجري لتدارك هذا النقص وإنشاء هذه العمارة الكبرى"( ،)14وقد ذهب بعض الباحثين إلى ان
أ
اول من التفت إلى مقاصد الشريعة هو إبراهيم النخعي (ت96ه) وهو من التابعين"وكان
أ
إبراهيم النخعي بمنزلة سعيد بن المسيب الذي كان احد كبار التابعين( )15وقد عرف إبراهيم
أ أ أ
النخعي بالعودة إلى مقاصد الشارع في استنباط الحكام معتبرا ا ّن احكام هللا لها غايات وحكم
ّ
المذهب،وقسم َ
شافعي و مصالحّ ،ثم جاء عز الدين بن عبد السلم (ت660ه) الذي كان
أ أ أ
الحكام باعتبار النظر المصلحي إلى عبادات ومعاملت "فاما العبادات فإنها احكام تعبدية
أ
يجب العمل على ما رسمه الشارع لها،دون النظر إلى تعليلها بعلل عقلية ،واما المعاملت فإنه
أ أ
يمكن للعقل إدراك عللها واسبابها لنها مبنية على مصالح العباد خلفا للظاهرية"( )16ثم جاء
أ
الشاطبي الذي قفز بعلم المقاصد ،فوسع مجالهّ ،وعمق مباحثه ،وابان عن هذا العمل في
أ أ
ك تابه الموافقات ،وابرز المباحث التي اضافها في علم المقاصد هي:
-المصلحة وضوابطها.
EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583 252
ص ص 265-247 ّ
المجلد /13 :العدد( 02 :ماي . )2022 الممارسات ّالل ّ
غوية
أ
-نظرية القصد في الفعال ،وسوء استعمال الحق.
أ
-النوايا بين الحكام والمقاصد.
-المقاصد والعقل.
-المقاصد والجتهاد.
-الغايات العامة للمقاصد.
وقد أتاثر الشاطبي بالفقه المالكي الذي كان له أالثر البالغ في صنع فكره المقاصدي ّ
ونقاه
أ
من كلم الفلسفة والمتكلمين ،وتعد مرحلة الشاطبي هي مرحلة التاسيس الحقيقي للنظرية
أ أ
المقاصدية ،من خلل تتبع النصوص ليخلص ان الحكام الشرعية تهدف إلى مصالح العباد،
أ
فالمقاصد تهدف إلى تحقيق المصالح ،وإبطال المفاسد ،فقد اراد هللا تعالى بعباده الخير
والصلح ،لذلك ينبغي على الفقهاء والدارسين من ادارك مقاصد هللا تعالى من خلل النصوص
أ
الحكم ومصالح العباد فيالشرعية ،وفي هذا يقول ابن القيم" :الشريعة مبناها واساسها على ِ
المعاش،وهي عدل كلها ،ورحمة كلها ،وحكمة كلها"( )17وفي هذا تبيان للغايات السامية التي
أ
تهدف إليها الشريعة "فكل مسالةخرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها،وعن
أ
المصلحة إلى المفسدة،وعن الحكمة إلى العبث،فليس من الشريعة وإن ادخلت فيها
أ أ
بالتاويل"( )18وعلى هذا الساس فإن بناء المعنى عند علماء المقاصدية ل يقوم على العناصر
أ
اللغوية المكونة للنص الشرعي ،بل يتعداها إلى عناصر اخرى غير لغويةوتتقاطع هذه النظرة
أ
الصولية في فهم النصوص مع النظرة اللسانية التداولية التي تقوم على قصدية الخطاب في
أ
إدراك المعنى المراد "فل وجود لي تواصل عن طريق العلمات دون وجود قصدية وراء فعل
أ
التواصل"( )19وتشترك التداولية مع المقاصدية في اليات عديدة إلدراك المعنى ،وابرزها:
أ أ
القصدية ،والمقام ،وكذلك الحجاج الذي يقابله في علم الصول تعليل الحكام "ويضع
أ أ
اصحاب النظريات الصورية توكيدا كبيرا على بنية الجملة ،على حين يضع اصحاب نظريات
أ
الستعمال توكيدا اساسيا على اعتقادات المتكلمين ومقاصدهم"( )20فالمقاصد ليست مجرد
أ
معرفة ومتعة معرفية،بل هي علم ينتج عمل واثرا ،وقد سلكت المدرسة المقاصدية منهجا
EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583 253
ص ص 265-247 ّ
المجلد /13 :العدد( 02 :ماي . )2022 الممارسات ّالل ّ
غوية
أ
وسطيا بين التجاه اللفظي (المدرسة الظاهرية) والتجاه التقويلي،حيث ان التجاه اللفظي
أ أ
الظاهري يعتمد على حرفية النص من اجل الوصول إلى المعنى المراد،اما التجاه التقويلي فهو
أ أ
الذي يبالغ في التاويل معتمدا على الراي والتخمين دون وجود قرينة تثبت ذلك ،ومن نماذج
أ
النصوص التي تجاوز فيها بعض علماء الصول المعنى الحرفي لتحقيق مقصد معين ما ثبت عن
ّ أ أ
رسول هللاﷺفي قوله ":ال ل ُيصلين احد العصر إل في بني قريضة"( )21لقد اختلف الصحابة في
أ
فهم كلم الرسولﷺ ،فمنهم من فهم ا ّن المراد هو الستعجال في السير ،وخشي خروج وقت
أ أ
صلة العصر ،فا ّدوا الصلة قبل وصولهم إلى بني قريضة ،ومنهم من اخذ بظاهر كلم
أ ّ أ ّ الرسولﷺ ،ولم ُي ّ
ولما اخبروا النبيﷺ لم ُيعاتب احدا "فتفسير صل العصر إل في بني قريضة
أ
النصوص الشرعية يتجاذبه عادة اتجاهان ،اتجاه يقف عند الفاظ النصوص وحرفيتها ،مك تفيا
بما ُيعطيه ظاهرها ،واتجاه يتحرى مقاصد الخطاب ومراميه"( )22فالشرائع عند المقاصديين
أ
وضعت لتحقيق مصالح العباد ،ويرفضون ادعاءات الحداثيين الذين يتجاهلون النص من اجل
أ
تحقيق الحداثة حسب رايهم.
ثالثا -قضايا لغوية بين التجاه الظاهري والتجاه المقاصدي:
أ
ترتبط جدلية المعنى ببعض القضايا اللغوية التي خلقت نقاشا واسعا بين الصوليين
بسبب تمسك بعضهم بالمعنى الصريح (المباشر) ويمثلون التجاه الظاهري ،وجنوح البعض
أ
إلى المعنى المتضمن (غير المباشر) ويمثلون التجاه المقاصدي ،ومن ابرز هذه القضايا اللغوية
أ
التي اخترناها كنماذج( :التاويل ،المجاز ،الحذف).
أ أ ُ ّ أ أ
عد التاويل من ابرز القضايا التي عرفت جدل عند اللغويين والصوليين ،فما هو -1التاويل :ي
أ
التاويل من حيث اللغة ،ومن حيث الصطلح؟.
أ
ا-لغة:
أ
ورد في المعاجم اللغوية معاني متعددة لمصطلح التاويل:
EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583 254
ص ص 265-247 ّ
المجلد /13 :العدد( 02 :ماي . )2022 الممارسات ّالل ّ
غوية
()23
-بمعنى "تفسير ما يؤول إليه الشيء"
أ أ أ
-بمعنى "اخر المر وعاقبته( )24ويقال إلى شيء مال هذا المر؟ اي مصيره واخره وعاقبته.
أ أ
-ياتي التاويل بمعنى التعبير عن الرؤيا.
ب-اصطالحا:
أ
يعد مصطلح التاويل مصطلح تشترك فيه الدراسات اللسانية التي تهتم بدراسة المعنى
أ
المرتبط بالخطاب ،والدراسات الصولية التي تحدد المعنى المراد للخطاب الديني ،ففي
أ أ
الدراسات اللسانية تؤكد النظرية التاويلية على اعتماد التاويل في فهم الخطاب ،وذلك بمراعاة
السياق "فالمعاني التي ينتجها الخطاب هي معاني ضمنية تنتج اإليحاءات التي يفرزها السياق
ّ أ أ
اللساني...وتكشف عنها عملية التاويل"( )25والمدرسة الظاهرية ل تقبل التاويل إل ما كان
أ
معتمدا على ادلة وقرائن تصرف الظاهر عن ظاهره وحجتهم في ذلك قوله تعالى﴿ :فمن بدله
بعدما سمعه ،فانما اثمه على الذين يبدلونه﴾[البقرة ]181 ،فقد قال ابن حزم تعقيبا على هذه
أ
الية" :وليس التبديل شيء غير صرف الكلم عن وضعه ورتبته إلى غيرها ،بل دليل من نص او
أ
إجماع متيقن عنهﷺ(" ،)26وقد يكون التاويل محل إتباع الهوى،وهؤلء يصدق فيهم قوله
أ
تعالى﴿ :ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله﴾ [ال عمران ]07 ،وهذا ما يذكره بعض الباحثين في
أ أ
إشكاليات التاويل في الحركات اإلسلمية المعاصرة تكون عمليات التفسير والتاويل محكومة
أ أ أ
في الغالب بسياقين :اولهما السياق المعرفي الموضوعي الذي يمكن ان نطلق عليه الفق
أ
المعرفي للمفسر وهو (افق ذاتي \ سسيو تاريخي) في نفس الوقت والسياق الثاني هو سياق
أ أ
النص موضوع التاويل سواء كان النص هو القران الكريم ،اوالحديث النبوي الشريف(،)27
أ وبشكل عام ّ
فإن التجاه الظاهري ل يقبل التاويل إل ماورد كحالت خاصة.
أ أ
ويعد التاويل في المدرسة المقاصدية الوسيلة البرز في الوصول إلى المعاني التي تحقق
المصالح من خلل التوفيق بين النقل والعقل "فالسير في هذا التجاه من لوازم قبول التوفيق
أ
بين النقل والعقل ،وما نتج عنهما من تاويل بحسب مفهوم مقاصد الشريعة الذي طوره فقهاء
أ
المالكي"( )28لكن المقاصديين يرون ا ّن قاعدة العمل بالظاهر مجتمع عليها،ما لم يقم دليل
EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583 255
ص ص 265-247 ّ
المجلد /13 :العدد( 02 :ماي . )2022 الممارسات ّالل ّ
غوية
على لزوم ترك المعنى المتبادر ،فإذا قام دليل كاف يرجح الباطن على الظاهر فإنه يصار إليه
أ
استثناء،فقد ذهب ابن تيمية (ت728ه)إلى ا ّن صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى
أ
المرجوح لدليل مقترن به ،وله معنيان :احدهما تفسير الكلم وبيان معناه سواء وافق ظاهره
أ أ
اوخالفه فيكون لفظ التاويل مرادفا للتفسير ،والمعنى الثاني هو نفس المراد بالكلم،فإن الكلم
إن كان طلبا كان أتاويله نفس الشيء المخبر به( ،)29ولهذا يرى ابن تيمية أبانه ليمكن تجاوز
أ
الظاهر وحمل اللفظ على خلفه في الفاظ القران والحديث إل بتطبيق ضوابط معينة ،وحتى ل
أ أ
ياخذ التاويل منحى الزيغ فإن العلماء وضعوا له ضوابط وشروطا ترتبط بالمؤول (اللفظ الظاهر)
أ
والمؤول (المجتهد) والمؤول به ،واهمها:
-ضرورة اللتزام بوحدة مصدر التشريع "فالنصوص الشرعية ل تعارض بعضها بعضا وعليه
فإن كل ما بدا فيه التخالف فإنما هو بحسب ذهن السامع ل بحسب الحقيقة( )30لذلك ينبغي ّ
أ
التامل في الظواهر المتعارضة.
أ
-الشرع والعقل ل يتناقضان ،وفي هذا تنقسم الدلة العقلية إلى قطعية وظنية ،ول يمكن
أ أ
للدلة الظنية ان تكون راجحة على ظاهر النص إذا تعارضا.
-التوافق بين ظواهر النصوص وبين مقاصدالشرع،فالكليات الشرعية تثبت بالنصوص
أ أ أ
القطعية اوبالستقرار،فإذا وجدنا نصا يعارض قاعدة كبرى اومقصدا اساسيا،كان ذلك النص
أ أ أ
داخل في إطار الظواهر المحتملة للتاويل،بل قد يتحتم تاويله ويلزم( )31ففي هذا يبدو ا ّن
المقاصديين يرجحون العقل على النقل.
أ أ أ أ
-ان تكون علقة اللفظ بالمعنى الذي يراد تاويله تتميز بالحتمال ،اي ان اللفظ يحتمل
أ
ذلك المعنى،ويكون هذا الحتمال موافقا لوضع اللغة،او عرف الستعمال.
أ
-رجحان الدليل (القرينة) الذي يسند إليه التاويل.
-ك فاية الدليل في صرف اللفظ عن ظاهره ،وعليه فإن نتيجة هذا الستدلل متعلقة
بعاملين:
EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583 256
ص ص 265-247 ّ
المجلد /13 :العدد( 02 :ماي . )2022 الممارسات ّالل ّ
غوية
أ
ا -قوة ظهور المعنى وضعفه.
ب -قوة الحتمال وضعفه.
أ أ أ
وواضح ا ّنه كلما كان المعنى في ظاهر النص اقوى ،كان الحتمال للتاويل
أ
اضعف،والعكس صحيح.
-2المجاز:
لقد ارتبط المجاز بجوهر الخلف بين المعنى الصريح (الظاهر) والمعنى المتضمن
أ
(المضمر) فاختلف علماء الصول بين إثبات وقوع المجاز في اللغة والقران،وبين إنكار وجوده:
أا -فريق ينكر المجاز في اللغة والقران أوابرز رواد هذا التجاه أاصحاب المذهب الظاهري
أ
وحجتهم في ذلك ان اللغة وضع تتفرع عنه معاني مجازية من خلل استعمال اللفظ في غير ما
أ
وضع له ،وكذلك إنكار التجريد واإلطلق في التراكيب اللغوية،بل هي دائما مفيدة باي نوع
أ أ
من القيود ،وهذا واد لفكرة المجاز،ل ّن المجازيين يقولون إن التركيب المطلق الخالي من
أ
التقيد بالقرائن المجازية حقيقة لغوية اما المقيد بتلك القرائن فهو المجاز( )32ومن ردود الذين
أ
انكروا المجاز في القران الكريم ما ورد في قوله تعالى﴿ :وسئل القرية﴾ [يوسف]09 ،
أ أ
"فالمضاف المحذوف كانه مذكور لنه مدلول عليه بالقتضاء وتغيير اإلعراب عند الحذف من
أ أ أ أ
اساليب اللغة"( )33ولعل اشهر الراء عند علماء الصول الذين انكروا المجاز في اللغة والقران ما
أ
ذهب إليه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في ان التفريق بين الحقيقة والمجاز غير مقبول إل إذا
أ أ
ثبت ان مجموعة من الناس اجتمعوا واتفقوا على إسناد اسماء إلى ما هو موجود في العالم
أ
الخارجي،ثم استخدموا تلك ال لفاظ لتلك المعاني ،وبعد اجتماع اخر وافقوا على استخدام
أ أ
ال لفاظ نفسها لمعاني مختلفة بمقتضى العلقة بين المعاني الصلية ،والمعاني الطارئة ،وفي
هذا إنكار شديد لوجود المجاز.
ب -فريق يدافع على وجود المجاز وحجتهم في ذلك وجود القرينة اللغوية التي تجعل
أ أ
المعنى المراد يخرج عن المعنى الصلي الظاهر (الحقيقة) فقد "تدل كلمة (اسد) على الحيوان
أ
المفترس دون حاجة إلى قرينة،ولكنها تحتاج إلى قرينة لإلشارة إلى الرجل الشجاع"( )34كما انه
EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583 257
ص ص 265-247 ّ
المجلد /13 :العدد( 02 :ماي . )2022 الممارسات ّالل ّ
غوية
تعد المعاني الحقيقية للفظ وغيرها بمثل المعاني يمكن للفظ أان تتعدد معانيه ،وبهذا ّ
أ أ أ أ
المجازية ،فإذا سالت احدهم عن معنى كلمة (اسد) مجردة من السياق ،فإنه سيجيبك انه
أ أ أ أ
تعني (الحيوان المفترس) او(ملك الغابة) اونحو ذلك،اما إذا وضعتها في السياق نحو( :رايت
أ أ أ أ أ
اسدا يشهر سيفه) فإنه سيجيبك انها تعني (الرجل الشجاع) اونحو ذلك ،ومن ابرز الصوليين
أ
الذين اثبتوا وجود المجاز في اللغة والقران الزمخشري (538ه) وفخر الدين الرازي (606ه)
وابن حجر العسقلني (777ه) وذهب اإلمام الشوكاني (1250ه) إلى رمي الذين ينكرون المجاز
أ
بالجهل "ويطلق الجرجاني على المجاز بمعنى المعنى ،ا ّما في البحث اللساني الحديث ُيسمي
غرايس ( )Paul Griceذلك بالمعنى غير الطبيعي ،كما ُيسميه سيرل()John Searleبالمعنى
أ أ
غير الحرفي ،وبمعنى ملفوظ المتكلم"( )35ويرى هذا الفريق من علماء الصول ان المجاز واقع
أ
في القران الكريم ،فالقران نزل بلغة العرب ،وهو واقع ايضا في السنة النبوية،ومن نماذج
أ أ أ أ
ذلك قوله عليه الصلة والسلم لمعاذ بن جبل" :ال اخبرك براس المر وعموده وذروة سنامه؟
أ أ
قال :بلى يا رسول هللا ،قال :راس المر الدين ،وعموده الصلةوذروة سنامه الجهاد في سبيل
أ أ
هللا"ففي الفاظ هذا الحديث معاني مجازية متعددة ،حيث جعل اإلسلم راس الدين ،وجعل
أ أ أ
الصلة عموده الذي به قوامه ،وعليه قيامه ،وجعل الجهاد ذروة سنامه ،لنه يعد الراس اعلى
أ أ أ
مشارفه واعلى مراتبه ،وبه يشاد بناؤه،ويقام لواؤه ،ويقمع اعداؤه"( )36ويرى الصوليون الذين
أ أ
يدافعون عن وجود المجاز ان الحقيقة هي الصل الظاهر في الكلم ،ول يحمل على المجاز إل
أ أ
استثناء ،لذلك يعد القول بالمجاز وجه من اوجه التاويل.
-3الحذف:
يعد الحذف ظاهرة لغوية ارتبطت بالبلغة والبيان ،فما هو الحذف في اللغة
والصطلح؟.
أ
ا-لغة:
أ
الحذف هو اإلسقاط "وحذف الشيء إسقاطه ،وحذفه بالعصا إذا رماه بها ،وحذف راسه
أ
بالسيف إذا ضربه فقطع منه قطعة"( )37ومنها ما ُيقال ل تحاذف اي ل ترم.
EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583 258
ص ص 265-247 ّ
المجلد /13 :العدد( 02 :ماي . )2022 الممارسات ّالل ّ
غوية
ب-اصطالحا:
أ ،وي ّ
هو إسقاط جزء من الكلم لدليل يدل على المحذوف ُ
عد الحذف ِقسما من اقسام
أ
اإليجاز فاإليجاز إيجاز قصر،وإيجاز حذف ،والعرب ل يحذفون ما ل دللة عليه ،ل ّن هذا ُينافي
غرض وضع الكلم عندهم.
أ
يعتبر البلغيون ا ّن من شروط البلغةاإليجاز والختصار ،وحذف فضول الكلم وذلك
أ
بالتعبير عن المعاني الك ثيرة بال لفاظ القليلة ،ويتحدث عبد القاهر الجرجاني عن بلغة الحذف
الماخذ ،عجيب أالمر ،شبيه بالسحر فإنك ترى أ
ومزاياه ،فيقول " :باب دقيق المسلك ،لطيف
( ُّ ُ )38أ أ أ
به ترك الذكر افصح من الذكر ،والصمت عن اإلفادة ازيد لإلفادة" ويعد الصل في الكلم
أ أ أ
الذكر ،والحذف خلف للصل،لذلك ينبغي ان يتوفر الكلم على الدلة و القرائن التي تدل
ّ أ
ولبد ان يخضع للقبول اللغوي الذي يجعل السامع يدرك المحذوف بواسطة القرائن عليه،
أ ّ أ ّ أ
المقالية او الحالية ،ويعد الذكر ملزما للمعنى الصريح (المباشر) اما الحذف فهو اقرب إلى
أ
المعنى المتضمن ،وغالبا ما يرتبط الحذف باسباب مختلفة مثل ك ثرة الستعمال وهذا ما يؤكده
أ
سيبويه بان ك ثرة الستعمال سبب قوي في تغيير الكلم ،كما يقع الحذف تجنبا لإلطالةوقد
أ
ورد عن البلغيين ان في اإليجاز إفهاما ،وفي اإلطالة استبهاما ،والستبهام من الكلم المبهم،
أ أ
ويرد هذا ك ثيرا في اسلوبويقع كذلك عند التنبيه -على ان الزمان ليتسع لإلتيان بالمحذوفِ -
اإلغراء والتحذير نحو قولنا:الصدق الصدق ،وتقدير الكلم :الزم الصدق الصدق،وكذلك
أ
التحذير في قوله تعالى( :ناقة هللا وسقياها) اي احذروا ناقة هللا،فل تقربوها على التحذير،
والزموا سقياها على اإلغراء.
ج -شروط الحذف:
أ أ
ينبغي ان تتوفر شروط معينة حتى يجوز الحذف ،واهمها ما يلي:
أ
-1وجود دليل على المحذوف ،ويكون هذا الدليل مقاليا اوحاليا "قد يكون اإليجاز في
أ أ أ
الدليل ابلغ اثرا في المستمعّ ،مما لو عمد المستدل إلى بسط دليله بسطا ،ذلك ا ّن
EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583 259
ص ص 265-247 ّ
المجلد /13 :العدد( 02 :ماي . )2022 الممارسات ّالل ّ
غوية
أ
المشاركة المطلوبة من المستمع في تقدير ما ُحذف من الدليل تجعله وكا ّنه لم ُيحمل
( )39 على النتيجة حملّ ،
وإنما وصل إليها بمحض إرادته"
أ أ
-2ال يكون المحذوف جزءا اساسيا في تركيب الجملة ،فإذا كان المعنى ل يك تمل إل بذكر
المحذوف ،فل يجوز الحذف.
أ
-3ال يكون المحذوف عامل ضعيفا ،فل يجوز حذف الفعل،إل في المواضع التي ك ثر فيها
استعمال هذه العوامل.
-4عدم وقوع اللبس ،فإذا كان الحذف يؤدي إلى اللبس في الفهم،فإنه ل يجوز،ولعل هذا
أ
الشرط يتداخل مع شرط وجود الدليل على المحذوف،على اعتبار ان الدليل يشير
إلى تقدير المحذوف،ويرفع اللبس على المخاطب.
أ أ أ
ويمكن ان نقول ان الحذف كظاهرة بلغية لم تجد خلفا بين علماء الصول من حيث
أ
المعنى الناتج ،إذ يتفق التجاه الظاهري والتجاه المقاصدي في تقدير المحذوف في اغلب
النصوص الدينية وهذا بسبب عدم وجود اللتباس ،ووجود القرينة الدالة على المحذوف.
خاتمة:
أ
-يرتبط المعنى الصريح عند علماء الصول بالتجاه الظاهري ،ويرتبط المعنى المتضمن
بالتجاه المقاصدي.
أ أ
-جل الحكام الشرعية الصادرة عن الظاهرية مرتبطة بظاهر اللفظ ،وجل الحكام الصادرة
عن المقاصديين مرتبطة بقصدية الخطاب ومدى تحقيقيها لمصالح العباد.
أ
-توجد مقاربة واضحة في طرق دراسة المعنى بين اللسانيين والصوليين ،فالتجاه
الظاهري يقارب التجاه الصوري الذي يعتمد على العناصر اللغوية ،والنغلق على النص وبنيته
أ أ
من اجل الوصول إلى المعنى المراد ،اما التجاه المقاصدي فيقابله التجاه التداولي الذي يعتمد
على العناصر اللغوية ،وغير اللغوية ،في الوصول إلى المعنى المراد ،كالقاصدية والمقام
وغيرها.
EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583 260
ص ص 265-247 ّ
المجلد /13 :العدد( 02 :ماي . )2022 الممارسات ّالل ّ
غوية
أ أ أ
-يعد التاويل مسالة خلفية واضحة بين الظاهرية والمقاصديين ،فمجال التاويل عند
أ أ
الظاهرية يكاد يكون منعدما ،اما التاويل عند المقاصديين فمجاله واسع ما كان ملتزما
بضوابطه.
أ أ
-يعد المجاز من القضايا اللغوية التي تحدث القطعية بين انصار المعنى الصريح وانصار
أ
المعنى المتضمن ،لن الختلف يصل إلى درجة بعض المسائل العقائدية وبخاصة ما يتعلق
أ
بإثبات صفات هللا اوتعطيلها.
-يعد الحذف من الظواهر اللغوية التي تعرف توافقا بين المعنى الصريح والمعنى
أ أ
المتضمن ،وذلك بسبب الشروط الصارمة التي ينبغي ان تتوفر في اسلوب الحذف وبخاصة
ضرورة رفع اللبس ،ووجود القرينة الدالة على المحذوف.
الهوامش:
( )1أاحمد بكير محمود ،المدرسة الظاهرية بالمشرق والمغرب ،دار قتيبة ،بيروت ،ط ،1990 ،1ص.21
أ
( )2الذوادي بن بخوش قوميدي ،تاويل النصوص في الفقه اإلسلمي ،دار ابن حزم ،بيروت ،ط،2009 ،1ص.439
( )3المرجع السابق ،ص .439
( )4أاحمد بكير محمود ،المدرسة الظاهرية ،ص.42
أ أ
()5علي بن أاحمد بن سعيد بن حزم ،اإلحكام في أاصول الحكام ،دار الفاق الجديدة ،بيروت ،ط ،2008 ،2ج،1
ص.71
أ أ أ
( )6اعلي بن احمد بن سعيد بن حزم ،اإلعراب عن الحيرة واللتباس الموجودين في مذاهب اهل الراي والقياس،
دار أاضواء السلف ،الرياض ط2005 ،1م،ص.171
أ
()7الذوادي بن بخوش قوميدي ،تاويل النصوص في الفقه اإلسلمي ،ص .441
أ
()8ابن حزم ،اإلحكام في أاصول الحكام ،ج ،8ص.91
أ
()9علي محمود الصراف ،الفعال اإلنجازية في العربية المعاصرة ،ط .1القاهرة ،2010 :مك تبة الداب .ص.98
()10عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ،الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ،دار الك تب العلمية ،بيروت،
ط1417 ،1ه ،ج ،3ص.66
()11جمال الدين بن منظور ،لسان العرب ،دار صبح واد سوفت ،بيروت ،ط2006 ،1م،ج ،2ص.96
EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583 261
ص ص 265-247 ّ
المجلد /13 :العدد( 02 :ماي . )2022 الممارسات ّالل ّ
غوية
( )12محمد الطاهر بن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسلمية ،دار الك تاب اللبناني ،بيروت،د ط2011 ،م،ج ،3
ص.165
()13المرجع نفسه ،ج ،3ص .165
( )14ينظر ابراهيم بن موسى الشاطبي ،الموافقات ،ت :عبيدة مشهور بن حسن ،دار بن عفان ،ط1997 ،1م ،ج،1
ص.6
()15هادي العبيدي ،الشاطبي ومقاصد الشريعة ،دارقتيبة ،بيروت ،ط ،1992 ،1ص.134
()16المرجع السابق ،ص .136
ابن حسن ،دار الك تب العلمية، مشهور ( )17ابن القيم الجوزبة،إعلم الموقعين عن رب العالمين ،تحقيق:
بيروت .2008 ،ج ،3ص.5
()18المرجع نفسه ،ص.5
(William, Bright ; International Encyclopedia of linguistics,Volume 3,1992,p258.)19
أ
( )20ينظرإسماعيل صلح،النظرية القصدية في المعنى ،حوليات الدب والعلوم الجتماعية ،دط ،2005 ،ص.38
( )21محمد بن إسماعيل البخاري ،صحيح البخاري ،ت :محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة ،بيروت،
ط1422 ،1ه ،ج ،2ص.15
( )22أاحمد الريسوني ،مدخل إلى مقاصد الشريعة ،دار السلفية،القاهرة ،:ط1996 ،1م ،ص.8
()23جمال الدين بن منظور ،لسان العرب ،مادة أ(اول) ،ج ،1ص .172
( )24أاحمدبن فارس ،الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلمها ،مك تبة المعارف ،بيروت،
ط ،1993 ،1ص .193
السلم عشير ،عندما نتواصل نغير ،مقاربة تداولية معرفية ل ليات التواصل والحجاج ،المغرب2006 :م، ( )25عبد ّ
إفريقيا الشرق ،ص.138
أ
()26الذوادي بن بخوش قوميدي ،الذوادي بن بخوش قوميدي ،تاويل النصوص في الفقه اإلسلمي ،ص.156
أ
()27نصر حامد أابو زيد ،الخطاب والتاويل ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء :المغرب ،ط ،2008 ،3ص.187
أ أ
()28عبد القادر فيدوح ،نظرية التاويل في الفلسفة العربية اإلسلمية ،دار الوائل للنشر ،مصر ،ط2005 ،1م،
ص.16
()29إبراهيم بن منصور التركي ،إنكار المجاز عند ابن تيمية ،دار كنوز اشبيليا ،الرياض ،ط1439 ،2ه ، .ص.87
أ
()30الذوادي بن بخوش قوميدي ،تاويل النصوص في الفقه اإلسلمي ،ص .170
()31المرجع السابق ،ص.170
( )32عبد العظيم ابراهيم محمد المطعي ،المجاز عند ابن تيمية وتلمذته بين اإلنكار واإلقرار ،مك تبة وهبة ،القاهرة،
ط ،1995 ،1ص.9
أ
( )33محمد المين بن محمد الشنقبطي ،منع جواز المجاز في المنزل للتعبد واإلعجاز،دار عالم الفوائد ،جدة ،ط،1
،2009ص.27
EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583 262
ص ص 265-247 ّ
المجلد /13 :العدد( 02 :ماي . )2022 الممارسات ّالل ّ
غوية
( )34محمد محمد يونس علي،علم التخاطب اإلسلمي ،دارالمدار اإلسلمي ،بيروت ،ط ،2006 ،1ص .151
()35عبد الهادي بن ظاهر الشهري ،إستراتجية الخطاب مقاربة لغوية تداولية ،دار الك تاب الجديدة المتحدة،
بنغازي ،ط ،1،2003ص .380
( )36الشريف الرضي ،المجازات النبوية،تحقيق :كريم سيد محمد محمود ،دار الك تب العلمية ،قم إيران ،ط،1
،2007ص .375
()37ابن منظور ،لسان العرب ،مادة(ح ذ ف)
()38عبد القاهر الجرجاني ،دلئل اإلعجاز ،تحقيق :محمود محمد شاكر ،مطبعة المدني ،القاهرة ،د ط،2008 ،
ص.104
()39عبد الهادي بن ظاهر الشهري ،إستراتجية الخطاب مقاربة لغوية تداولية ،ص.150
قائمة المصادر والمراجع:
-1إبراهيم بن منصور التركي ،إنكار المجاز عند ابن تيمية ،ط،2دار كنوزاشبيليا ،الرياض،
1439ه.
-2ابراهيم بن موسى الشاطبي ،الموافقات ،تح :عبيدة مشهور بن حسن ،ط،1دار بن عفان،
.1997
-3ابن القيم الجوزية،إعلم الموقعين عن رب العالمين ،دار الك تب العلمية ،بيروت.2008 ،
أ
-4احمد ابن فارس ،الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في
كلمها،ط،1مك تبة المعارف ،بيروت.1993،
أ
-5احمد الريسوني ،مدخل إلى مقاصد الشريعة،ط،1دار السلفية ،القاهرة.1996 ،
أ
-6احمد بكير محمود ،المدرسة الظاهرية بالمشرق والمغرب ،ط،1دار قتيبة،بيروت.1990،
أ
-7إسماعيل صلح ،النظرية القصدية في المعنى،حوليات الدب والعلوم الجتماعية.2005 ،
-8البخاري ،صحيح البخاري،تح :محمد زهير بن ناصر الناصر ،ط ،1دار طوق النجاة،
بيروت1422،ه .
أ
-09الذوادي بن بخوش قوميدي ،تاويل النصوص في الفقه اإلسلمي ،ط،1دار ابن حزم،
بيروت.2009 ،
EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583 263
ص ص 265-247 ّ
المجلد /13 :العدد( 02 :ماي . )2022 الممارسات ّالل ّ
غوية
-10الشريف الرضي ،المجازات النبوية ،تح :كريم سيد محمد محمود،ط ،1دار الك تب
العلمية ،إيران.2007 ،
-11جمال الدين ابن منظور،لسان العرب ،ط،1دار صبح واد سوفت،بيروت.2006 ،
السلم عشير ،عندما نتواصل نغير ،مقاربة تداولية معرفية ل ليات التواصل -12عبد ّ
والحجاج ،إفريقيا الشرق ،المغرب.2006 ،
-13عبد العظيم ابراهيم محمد المطعي ،المجاز عند ابن تيمية وتلمذته بين اإلنكار واإلقرار،
ط ،1مك تبة وهبة ،القاهرة.1995 ،
-14عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ،الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ،ط ،1دار
الك تب العلمية ،بيروت1417 ،ه.
أ أ
-15عبد القادر فيدوح ،نظرية التاويل في الفلسفة العربية اإلسلمية ،ط ،1دار الوائل ،مصر،
.2005
-16عبد القاهر الجرجاني ،دلئل اإلعجاز ،تح :محمود محمد شاكر ،مطبعة المدني ،القاهرة،
.2008
-17عبد الهادي بن ظاهر الشهري،إستراتجية الخطاب مقاربة لغوية تداولية ،ط ،1دار الك تاب
الجديدة المتحدة ،بنغازي.2003 ،
أ
-18عليبن احمد بن سعيد ابن حزم ،اإلعراب عن الحيرة واللتباس الموجودين في مذاهب
أ أ أ
اهل الراي والقياس ،ط ،1دار اضواء السلف ،الرياض.2005 ،
أ أ أ أ
-19علي بن احمد بن سعيد ابن حزم ،اإلحكام في اصول الحكام ،ط،2دار الفاق الجديدة،
بيروت.2008 ،
أ
-20علي محمود الصراف ،الفعال اإلنجازية في العربية المعاصرة ،ط ،1مك تبة الداب،
القاهرة.2010 ،
أ
-21محمد المين بن محمد الشنقيطي ،منع جواز المجاز في المنزل للتعبد واإلعجاز ،ط،1
دار عالم الفوائد ،جدة.2009 ،
-22محمد الطاهر ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسلمية ،دار الك تاب اللبناني ،بيروت،
.2011
EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583 264
ص ص 265-247 ّ
المجلد /13 :العدد( 02 :ماي . )2022 الممارسات ّالل ّ
غوية
-23محمد يونس علي ،علم التخاطب اإلسلمي ،ط،1دار المدار اإلسلمي ،بيروت.2006 ،
أ أ
-24نصر حامد ابو زيد ،الخطاب والتاويل ،ط ،3المركز الثقافي العربي ،المغرب.2008 ،
-25هادي العبيدي ،الشاطبي ومقاصد الشريعة ،ط ،1دار قتيبة،بيروت.1992 ،
Bright , W. (1992). International Encyclopedia of linguistics -26
EISSN :2602-5353 / ISSN : 2170-0583 265
You might also like
- التأويل وجدلية الدلالة عند الحداثيينDocument4 pagesالتأويل وجدلية الدلالة عند الحداثيينsebai lakhdarNo ratings yet
- تعريف التفسير الموضوعيDocument21 pagesتعريف التفسير الموضوعيAbdul Muis100% (2)
- د. أحمد عرابي، جدلية الفعل القرائي عند علماء التراثDocument26 pagesد. أحمد عرابي، جدلية الفعل القرائي عند علماء التراثAnnalesNo ratings yet
- مناهج البحث في الاعلامDocument23 pagesمناهج البحث في الاعلامMohamed Tayeb SELT80% (5)
- العدول عن المقتضى النحوي في تفسير النص القراني للاعتقاد بالله تعالى - د. أحمد خضير عباسDocument25 pagesالعدول عن المقتضى النحوي في تفسير النص القراني للاعتقاد بالله تعالى - د. أحمد خضير عباسAhmed kh. AbbsNo ratings yet
- مدخل السبعDocument11 pagesمدخل السبعAbdo sh (abdo)No ratings yet
- أهمية علم النحو في فهم النص الشرعيDocument19 pagesأهمية علم النحو في فهم النص الشرعيKamran Asat IrsyadyNo ratings yet
- 97-Article Text-249-1-10-20220325Document18 pages97-Article Text-249-1-10-20220325Wahyudi BuskaNo ratings yet
- الحلّ القصــديّ للغة في مواجهة الإعتباطيةDocument528 pagesالحلّ القصــديّ للغة في مواجهة الإعتباطيةabubasilNo ratings yet
- 42الألفاظ المشتركة في القرآن الكريمDocument19 pages42الألفاظ المشتركة في القرآن الكريمAHLAM LOOVENo ratings yet
- محاضرة قضايا نقدية لماستر المناهجDocument4 pagesمحاضرة قضايا نقدية لماستر المناهجimane toubalNo ratings yet
- Skripsi Arab Bab 1-5 (إسما ينتي)Document49 pagesSkripsi Arab Bab 1-5 (إسما ينتي)Ridha MustaufidaNo ratings yet
- Alae Ech Charkaouy 11 (1) - 1Document28 pagesAlae Ech Charkaouy 11 (1) - 1قناة محمد سعيد أراروNo ratings yet
- خطة الإختلاف في دخول المخاطب على عموم خطابةDocument8 pagesخطة الإختلاف في دخول المخاطب على عموم خطابةمتفائل في زمن اليأسNo ratings yet
- 1 PBDocument9 pages1 PBAhmad ShohibNo ratings yet
- مفهوم في سبيل الله في منظوري اللغة والفقهDocument18 pagesمفهوم في سبيل الله في منظوري اللغة والفقهbadroes samsNo ratings yet
- Ge3bi Saliha 15 24Document10 pagesGe3bi Saliha 15 24mustapha mediuNo ratings yet
- تداولية الخطابDocument162 pagesتداولية الخطابamzilamzil2020No ratings yet
- آليات وضع المصطلح في النقد العربي، تلقي مصطلح التفكيك أنموذجاDocument23 pagesآليات وضع المصطلح في النقد العربي، تلقي مصطلح التفكيك أنموذجاfarouk.soltani1992No ratings yet
- SIAQAT Volume 5 Issue 1 Pages 112-121Document10 pagesSIAQAT Volume 5 Issue 1 Pages 112-121karozasweetNo ratings yet
- النص بين انطولوجية المعنى ومشروعية التأويلDocument15 pagesالنص بين انطولوجية المعنى ومشروعية التأويلأيلول جبريلNo ratings yet
- 4 المشترك اللفظيDocument31 pages4 المشترك اللفظيmoualim moualimNo ratings yet
- مقدمةDocument15 pagesمقدمةAnugrah GiffariNo ratings yet
- الحل - القصــدي - للغة في مواجهة الإعتباطيةDocument387 pagesالحل - القصــدي - للغة في مواجهة الإعتباطيةtarigmelhajNo ratings yet
- بحث 7 128 148 مصطلح الطباق بين مركزية المعنى والتعدد الدلاليDocument21 pagesبحث 7 128 148 مصطلح الطباق بين مركزية المعنى والتعدد الدلاليmohd zoubiNo ratings yet
- التأويل لطيفة يوسفيDocument29 pagesالتأويل لطيفة يوسفيahmed benmohammedNo ratings yet
- الاختلافات في دخول المخاطب في عموم خطابةDocument32 pagesالاختلافات في دخول المخاطب في عموم خطابةمتفائل في زمن اليأسNo ratings yet
- 20المعنى عند المدارس اللسانيةDocument20 pages20المعنى عند المدارس اللسانيةافنان افنانNo ratings yet
- زيادة المعنى لزيادة المبنى - - مفهومها وضوابطها وأهميتها الدلالية-Increasing Structure for Increasing Meaning - Definition Precepts and Semantic SignificanceDocument21 pagesزيادة المعنى لزيادة المبنى - - مفهومها وضوابطها وأهميتها الدلالية-Increasing Structure for Increasing Meaning - Definition Precepts and Semantic Significanceusman wadeeNo ratings yet
- TapsirDocument6 pagesTapsirFadhillah AdkandaryNo ratings yet
- التأويلDocument8 pagesالتأويلDounia ElkhatiriNo ratings yet
- أثر تأصيل ألفاظ اللسان العربي في ضبط فهم ألفاظ القرآن الكريمDocument37 pagesأثر تأصيل ألفاظ اللسان العربي في ضبط فهم ألفاظ القرآن الكريمAHLAM LOOVENo ratings yet
- التقابل من بلاغة الجمل الى بلاغة النصDocument24 pagesالتقابل من بلاغة الجمل الى بلاغة النصAbdullah AlawiNo ratings yet
- مصادر التفسير بالرأي علاءDocument13 pagesمصادر التفسير بالرأي علاءhasaan rawiiNo ratings yet
- قرينة السياق واثرها في توجيه البحر المحيط - تفسير البحر المحيط انموذجا - د. احمد خضير عباسDocument22 pagesقرينة السياق واثرها في توجيه البحر المحيط - تفسير البحر المحيط انموذجا - د. احمد خضير عباسAhmed kh. AbbsNo ratings yet
- ضوابط نقد المتن عند المحدثين ١ و ٢Document16 pagesضوابط نقد المتن عند المحدثين ١ و ٢zoummaddottacei-4987No ratings yet
- 185151Document20 pages185151Rahil LallouniNo ratings yet
- تفسير الصوفية للقرآن الكريمDocument2 pagesتفسير الصوفية للقرآن الكريمpetit zbNo ratings yet
- التبادل بين جوابات الشرط في القرآنDocument24 pagesالتبادل بين جوابات الشرط في القرآنAbdul AzimNo ratings yet
- JFEHLS Volume 25 Issue 3 Page 223 273Document51 pagesJFEHLS Volume 25 Issue 3 Page 223 273ouffa fatma zahraNo ratings yet
- التداولية النشاة والأصولDocument15 pagesالتداولية النشاة والأصولsamiNo ratings yet
- الفصل الاولDocument6 pagesالفصل الاولahmed maanNo ratings yet
- نسيمة حمار المصطلح النحوى فى الكتاب لسيبويهDocument16 pagesنسيمة حمار المصطلح النحوى فى الكتاب لسيبويهzoldyckspirit1908No ratings yet
- DocumentDocument3 pagesDocumentLGD UnuNo ratings yet
- باب النقد 4 المصطلحات اللغويةdfDocument10 pagesباب النقد 4 المصطلحات اللغويةdfAska ShingalyNo ratings yet
- د. بلقاسم براهيم، العدول الصرفي بين التقعيد والتبرير لغة القرآن تأسيساDocument20 pagesد. بلقاسم براهيم، العدول الصرفي بين التقعيد والتبرير لغة القرآن تأسيساAnnalesNo ratings yet
- تلخيص كتاب علم لغة النص - المفاهيم والاتجاهات للدّكتور سعيد بحيري PDFDocument35 pagesتلخيص كتاب علم لغة النص - المفاهيم والاتجاهات للدّكتور سعيد بحيري PDFDr. Abdulkareem Okelan100% (5)
- (5) العلاقة بين اللفظ والمعنى وآراء القدامى والمحدثين فيهماDocument19 pages(5) العلاقة بين اللفظ والمعنى وآراء القدامى والمحدثين فيهماجعفر يايوشNo ratings yet
- ملخص مقرر مناهج المفسرينDocument72 pagesملخص مقرر مناهج المفسرينSaira MunirNo ratings yet
- مدخل إلى علم التفسيرDocument9 pagesمدخل إلى علم التفسيرmed AlphaNo ratings yet
- تطور مفهوم مصطلح أصول التفسير في المؤلفات وعلاقته بقواعد التفسيرDocument24 pagesتطور مفهوم مصطلح أصول التفسير في المؤلفات وعلاقته بقواعد التفسيرhamzamiz0No ratings yet
- لفروق بين المفهوم والمصطلح والتعريفDocument17 pagesلفروق بين المفهوم والمصطلح والتعريفTayeb Benbali100% (2)
- أثر السياق غير اللغوي في تأويل الفعل الكلاميDocument8 pagesأثر السياق غير اللغوي في تأويل الفعل الكلاميabedbaraa156No ratings yet
- المعجم الصوفى - المعجم4Document55 pagesالمعجم الصوفى - المعجم4petoeahNo ratings yet
- 31 3Document71 pages31 3محمد المطيريNo ratings yet
- إشكالية ترجمة المصطلح4Document70 pagesإشكالية ترجمة المصطلح4drissecho100% (1)
- IcpDocument9 pagesIcpPAJRIWATI RAJABNo ratings yet
- Mie É Polys PolysemyDocument19 pagesMie É Polys PolysemyMuhammet AteşNo ratings yet
- الاتجاه الباطني في تشكُّله الجديدDocument13 pagesالاتجاه الباطني في تشكُّله الجديدMuhammad AliNo ratings yet