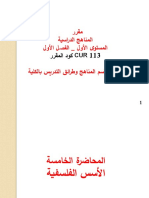Professional Documents
Culture Documents
Am-Rhanat Tdrys Alflsft Fy Alt LM Almdrsy-Ywsf BN Dy
Am-Rhanat Tdrys Alflsft Fy Alt LM Almdrsy-Ywsf BN Dy
Uploaded by
elalaouimohamed357Original Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Am-Rhanat Tdrys Alflsft Fy Alt LM Almdrsy-Ywsf BN Dy
Am-Rhanat Tdrys Alflsft Fy Alt LM Almdrsy-Ywsf BN Dy
Uploaded by
elalaouimohamed357Copyright:
Available Formats
ثان ًيا :من السؤال األيديولوج ّي إىل منطق التعلّمات ً
أول :التفاعل البيداغوج ّي والديداكتيك ّي في درس
سوف نجيب عن التساؤل األخير عىل مستويين :يتمثّل الفلسفة
المستوى األ وّل في أ ّن عالقة الفلسفة بالبيداغوجيا التربية هي نقل القيم األخالقيّة والدينيّة واالجتماعيّة إىل
ولعل النموذج األمثل في ّ والتدريسيّة عالقة تاريخيّة. األجيال الالحقة (روبول)1994 ،؛ بغية تكوين حصان ٍة ض ّد
رهانات تدريس
هذا السياق هو سقراط والسفسطائيّون؛ فكالهما كان يكسر بنياتها ونُظمها ،وقد تكون التربية بالمعنى
من أراد أن ّ
يعمل عىل تطوير اإلشكاليّة أو الفكرة بأسلوبين مختلفين، األكثر فاعليّة تحرير اإلنسان مما يمنعه من تحقيق ذاته
وكالهما يفيد المستمع والمخاطَب في تمثّل األفكار (الشرقي.)2017 ،
والتصوّرات ،رغم أ ّن الخلفيّة الثانويّة وراء هذين األسلوبين
رؤية مذهبيّ ًة قد تبدو لنا متضا ّد ًة؛ أي
التدريسيّين تحمل ً
نسبيّ ًة في الحقائق وثبوتها .لك ّن المفارقة هي أن تتّسم
ومما يفي ُد مد ّرس الفلسفة في التعليم المدرس ّي أنّه يعي الفلسفة في
التعلّم المدرس ّي
طبيعة العادات والتقاليد المقيّدة للفرد والمتعلّم ،ويحتاج
الفكرة بالموثوقيّة والمعقوليّة ،بينما يفتقد صاحبها نقده لهذه العادات إىل تمكين المتعلّمين من معرف ٍة
لألسلوب ،وهذا ما يشبه الدفاع الفاشل عن قضيّة عادلة. بانوراميّة بمفهوم ّي الثقافة والطبيعة؛ ما قد يمنعهم من
إ ّن البيداغوجيا والتلقين ونقل المعارف من المتكلّم إىل تبنّي أحكام جاهزة في المجاالت الثقافيّة واالجتماعيّة
بحث في المفارقات
عائقا أمام تصريف األفكار والدفاع المستمع قد ال يكون ً والدينيّة .كما يحتاج المد ّرس إىل توعية المتعلّمين بأ ّن
عنها .ومن ث ّم ،فتدريس الفلسفة بطرق بيداغوجيّة معينة تاريخ اإلنسانيّة هو تاريخ اختالف المعتقدات واألفكار
قد ال يفقد روح النقد لدى الفلسفة ،بل تكاد تكون المشكلة أيضا؛ وهذا ما يجعله يمارس النقد والتحليل والطبائع ً يوسف بن عدي
الحقيقيّة هي عمليّة النقل الديداكتيك ّي للمعلومات الطلب .لك ّن دوره يكون دو ًرا توجيه ًيّا وإرشاديًّا
ّ بمعيّة
وإل سنكون والمكتسبات العلميّة والفكر يّة واإلبداعيّةّ ، للنقاش الذي تثيره التساؤالت واإلشكاالت المتعلّقة
مثل من يتّهم المرآة ،ويتغافل عن اتّهام نفسه! حقق ماهيّة الفلسفة التي بالنقد .بهذا ،يكون المد ّرس قد ّ
هي المساءلة واإلحراج اإلشكال ّي Aporétiqueمن دون تدريس الفلسفة هي تهيئة المتعلّم ليكون مواطنًا ناق ًدا غن ٌّي عن البيان أ ّن تدريس الفلسفة في التعليم المدرس ّي
أما المستوى الثاني فيتعلق بأ ّن تدريس الفلسفة في أن يفقده ذلك خبرته البيداغوجيّة والتربويّة في تحيين ً
مسؤول؟ إىل أي ّ ح ّد يمكننا القول إ ّن تدريس الفلسفة هو تدريس لما ّدة َ
مثل بقيّة الموا ّد األخرى التي يُختبر
الكتاب المدرس ّي يحصرها في بعض المفاهيم والتفاصيل القضايا وتذليلها للمتعلّمين. مؤشرات تدريس الفلسفة هو تدريس للمهارات؟ ما هي ّ المتعلّمون في مدى تملّكهم بعض المهارات والكفايات
ً
مالئمة لتطوّر المجتمع العرب ّي وآفاقه، التي قد ال تكون ومستنداته؟ هل هذا يجعلنا ،م ّرة أخرى ،أمام وضع مقلق فيها طيلة السنوات الثالث في المرحلة الثانويّة التأهيليّة.
ً
غارقة في بل قد تكون الفلسفة في بعض الدول العربيّة ّ
المؤسسة، ليس من المفيد أن تبقى الفلسفة خارج بين دور المتفلسف ودور البيداغوج ّي؟ لذلك ،فالفلسفة التي نراهن عليها ليست بالمعنى
األيديولوجيا ،كأنها تحوّلت إىل خدمة أجندات معيّنة ،مع المؤسسة التربويّة والسياسيّة فرصة
ّ بل يتعيّن أن تتيح األكاديم ّي والعلم ّي الخالص؛ أي التيّارات والمدارس
فضل عنأ ّن منطق الفلسفة هو غير منطق األيديولوجياً . ممارسة الفهم والتأويل والقراءة لنصوص فلسفيّة يبدو أ َّن التفكير في تدريس الفلسفة ال يمكن بصورة ح ّرة الفكر يّة في تاريخ الفلسفة وتفاصيلها ،بقدر ما أنّها
ذلك ،فإ ّن بعض الممارسات المهنيّة تكون وفيّ ًة لرؤيتها من مختلف الحضارات العربيّة واإلسالميّة والوسيطة منظّمة؛ يتعيّن عىل أو مطلقة دون شروط أو نصوص ِ تروم – في التعليم المدرس ّي -تمكين المتعلّم من بعض
السياسيّة واأليديولوجيّة في عمليّة بناء الدرس الفلسف ّي فرصة لمحاولة مواجهة ٌ والحديثة والمعاصرة .إنّها مد ّرس هذه الما ّدة أن يطّل َع عىل هذه النصوص سوا ًء تعلّق العامة للفكر الفلسف ّي (النقد ،والتحليل، ّ الخصائص
ّ
الصف. داخل النص وتدارسه مع المتعلّم ،وكذلك تجريب قدرة ّ الحجاج،األمر بمنهجيّة تدريسها (المفهمة – األشكلة – ِ والحجاج ...إلخ) في قراءة بعض النصوص الفلسفيّة، ِ
المد ّرس عىل نقل المعرفة العالمة le savoir savantإىل الحقا) أو تقويمها وفق مستويات مرحلة ً كما سنوضح والثقافيّة ،والسوسيو-ثقافيّة ،المالئمة للنم ّو العقل ّي
تدريس الفلسفة مدرس ّيًا في المغرب المعرفة المدرسيّة le savoir scolaire؛ وهذا ما يس ّمى البكالوريا .من ث ّم ،فدرس الفلسفة في التعليم الثانوي ّ هو الوجدان ّي للمتعلّم.
ال ب ّد من التنبيه إىل أ ّن تدريس الفلسفة في التعليم المدرس ّي النقل الديداكتيك ّي ( transposition didactiqueجونايير أيضا ،بخالف المستوى الجامع ّي درس في البيداغوجيا ً
قد م ّر بتحوّالت كبيرة ،كان فيما سبق لأليديولوج ّي وبورخت .)2011 .فهل تفقد الفلسفة في هذا الوضع ّ
فلكل حيث يكون في األفكار والنظر يّات والتيّارات؛ يبحث هذا المقال في تساؤالت :لماذا ال ننتبه إىل أ ّن
الدور األساس ّي في قراءة النصوص الفلسفيّة والتراث ّ
(بشقيه البيداغوج ّي والتربويّ) روحها التعليم ّي التعلّم ّي مستوًى غاياته وأهدافه. تدريس الفلسفة في التعليم المدرس ّي هو ما ّدة تعليميّة
درس الفلسفة ً
درسا العرب ّي بصورة مباشرة ،حتى صار ُ النقديّة؟ نفسر أ ّن مه ّمة
مدرسيّة مثل بقيّة المواد األخرى؟ كيف ّ
خريف 2020 59 خريف 2020 58
يتفاعل فيها مع المد ّرس وزمالئه بالسؤال واالستفسار ّ
كالشك والمراجعة بنا ًء عليه ،فإ ّن ّ
مؤشرات النقد ،ولواحقه
ً إ ّن االطّالع عىل بنية الكتب المدرسيّة لما ّدة الفلسفة في في األيديولوجيا .من جهة الهندسة البيداغوجيّة ،يمكن
وإبداء الرأي ،بيد أ ّن المفارقات تظهر حينما يصطدم غائبة عن المق ّررات الدراسيّة بصورة والتشريح ،لم تكن
المغرب ،عىل سبيل المثال ال الحصر ،يجعلنا نستنتج أ ّن القول إ ّن البرنامج السائد حينها هو التدريس بالمضامين
هذا المتعلّم مع واقع العقالنّي ،حيث الكلمة العليا فيه حل المشكالت والفارقيّة من مطلقة ،بل إ ّن بيداغوجيا ّ
ّ
للفردانيّة المنحطّة والمنفعة ّ مؤشرات وجود الفكر الناقد بارزة ضمنها ،وتظهر في والمحتويات ،واالستناد إىل آليّات التحفيز وشحذ الهمم
نفكر أحيانًا
اللمشروعةّ . البيداغوجيّات الحديثة التي تمنح المتعلّم فرصة التعبير
صورة المتعلّم ،الذي أضحى الفاعل الحقيق ّي في بناء أما اليوم ،فقد أضحى والتأثير المباشر في المخاطَبّ .
بمنطق االنقالب عىل القيم واألخالق والعقل في سياق عن رأيه ووجهة نظره ،واإلحساس باالستقالل الذات ّي،
الدرس .فالمد ّرس لم يعد كما كان في سياق بيداغوجيا برنامج تدريس الفلسفة في التعليم المدرس ّي المغرب ّي
تعامله مع اآلخرين وأسرنا وأصدقائنا .إنّه منطق أضحى وبناء مشاريعه الشخصيّة .ومن المؤكد أ ّن فرصة مواجهة
تهدف إىل تفكيك سلوكاته التعلّميّة إىل أجزاء ،وتقييمها هو التدريس بالمفاهيم والتفاصيل ،ليكون الغرض هو
هو القاعدة ،بينما االلتزام بحقوق األفراد والجماعات المتعلّم بمعيّة مد ّرسه لنصوص فالسفة مثل ،Descartes
والدفاع عن إنسانيّة اإلنسان صار هو الطارئّ . و ، Kantو ،Husserlوابن رشد ،تمنحه ً بصورة آليّة ميكانيكيّة ،بل صار المتعلّم الهدف األساس ّي تمكين المتعلّم من قدرات وكفايات ومهارات يعمل
لعل ما أيضا قدرات عىل
في العمليّة التعليميّة – التعلّميّة ،بوساطة عمليّات التفاعل عىل استرجاعها .في المجمل ،هل تعود الفرادة في إنتاج
ند ّرسه في الفلسفة في حجرات الدرس بتقنيّات تدريسيّة التحليل والتركيب والتأويل والتقييم وفق المنطق الثالث ّي: البيداغوج ّي والتعلّم ّي مع المد ّرسً ،
فضل عن التركيز عىل النصوص الفلسفيّة التأسيسيّة إىل الطرق البيداغوجيّة
رفيعة ،وبيداغوجيا مثاليّة قد يسهم في خلق هذا النوع والحجاج.
األشكلة والمفهمة ِ
المهارات والكفايات النوعيّة :االستراتيجيّة والثقافيّة والتعلّميّة؟
من المفارقات في وجدان المتعلّم ،وقد يكون المد ّرس
والتواصليّة والمنهجيّة ،التي تدفع المتعلّم إىل التحلّي
السبب الرئيس في عرقلة ممارسة النقد وآليّاته ،بفعله خالصة
بالوعي النقديّ ،والقيام بالواجب ،وتح ّمل المسؤوليّة، تأم ٍل آخ َر لإلجابة عنه وفق يحتاج هذا السؤال إىل ّ
المعرف ّي وطريقة إدارته للدرس وتخطيطه وتعامله مع خاصةأعتقد أ ّن الصراع بين المدافعين عن بيداغوجيا ّ
والتخل ّي عن السلبيّة واالتّباع والتفكير الخراف ّي. المقارنات الدقيقة بين الكتب المدرسيّة والمق ّررات
المتعلّمين. بالدرس الفلسف ّي وبين المناصرين لفكرة استفادة ما ّدة
المعتمدة في التعليم المدرس ّي ،وكذلك رصد النظر يّات
الفلسفة -كما ّدة مدرسيّة -من علوم التربية ،لم يعد يثير
يوسف بن عدي االهتمام اليوم؛ أل ّن الفكر أضحى ّ مثلّث الروح النقديّة :األشكلة والمفهمة ِ
والحجاج البيداغوجيّة التي كانت تعين عىل تصريف الدرس
مرك ًبا ومتع ّدد األبعاد الفلسف ّي .لقد أسهمت الثقافة المغربيّةً ،
ال يخفى دور الجانب الديدياكيتك ّي في شحذ تلك الروح مثل ،في
أستاذ الفلسفة بالمركز الجهوي ّ والوظائف .ومن ث ّم ،هل الفلسفة تحتاج إىل بيداغوجيا
ٌ النقديّة المتمثلّة في مثلث ميشيل طوزي (:)2018 إنتاج نصوص فلسفيّة تأسيسيّة مع محمد عزيز لحبابي
لمهن التربية والتكوين سؤال أيديولوج ّي خاص بمنهجيّة التدريس؟ إنهوخطاب ّ
األشكلة Problématisationالتي تسعى إىل وضع المتعلّم أيضا نقف ومحمد عابد الجابري وعبد هللا العروي .هنا ً
المغرب في جوهره .تتعلّق المسألة برصد أسباب تراجع التفكير
ّ في وضع محرج ومفارق يحفزّه عىل استدعاء موارده عند مفارقة نعبّر عنها بالسؤالين التاليين :لماذا أنتجت لنا
ومؤشراته في التعليم المدرس ّي؛ ذلك التفكير الناقد المعرفيّة المكتسبة ّ
الذي ّ لحل هذه الوضعيّة سوا ًء أكانت عمليّة الفلسفة في السبعينيّات والثمانينيّات من القرن الماضي
يغذيه تدريس الفلسفة بالدرجة األوىل .حينما يقرأ
أم نظر يّة .والمفهمة Conceptualisationالتي يُطلب من فك ًرا فلسف ًيّا وتنظي ًرا أيديولوج ًيّا كبي ًرا في غياب الهواجس
المتعلّم نصوص رينيه ديكارت ،وابن رشد ،و”شذرات”
المتعلّم أن يرصد تحوّالت المفاهيم في ّ
النص الفلسف ّي البيداغوجيّة والتدريسيّة؟ ولماذا يكاد يغيب ذلك النوع
فريدريك نيتشه ،ورسالة في التسامح لجون لوك في ودورها في ّ
ّ تشكل ما يس ّمى السند .Supportومن ث ّم، من اإلنتاج الفلسف ّي في ظل الع ّدة البيداغوجيّة الضخمة؟
الصف الدراس ّي ،فإنّه يعيش لحظات تنوير يّة وعقالنيّة
ّ
الترصد الحل ّإل عن طريق
ّ فاألشكلة لم يكن لها طريق كأنّنا هنا ال نكاد نخرج من مفارقةّ ،إل ونقع في أخرى .ال
المفاهيم ّي ،ودوره في السياقات المختلفة في إنشاء ب ّد من االعتراف أ ّن لغة التعميم األيديولوج ّي والتقسيمات
ّ
والتعقل والنقد ّ
محل القراءة هذه الفلسفة التي هي البسيطة لألفكار والتصوّرات لم تعد لها مكانة في ثقافتنا
الحجاج للفلسفات األخرى بصورة ظاهرة أو خفيّة .أما ِ ً
سابقا، اليوم ،وال سيّما أ ّن الفكر الفلسف ّي لم يعد كما كان
المراجع: ً
مرحلة أساسيّة في عمليّة قراءة Argumentationفيع ّد مركب
ٌ بل صار فك ًرا متداخل األبعاد والوظائف؛ إنّه فك ٌر
قراءة منظّمة ،تدفع المتعلّم إىل كشف ً ّ
النص الفلسف ّي أيضا يساوقه طبيعته في إنتاج فكر ما يجعل البيداغوجيا ً
-جونايير ،فيليب؛ وبورخت ،سيسيل ( .)2011التكوين الديداكتيكي للمدرسين :التدريس بالكفايات من خالل خلق شروط التعلّم .ترجمة عبد الكريم غريب وعز
الدين الخطابي .مطبعة النجاح الجديدة. االستراتيجيّات اللغويّة والبالغيّة والمنطقيّة التي كانت مركب متع ّدد األبعاد ،كما يقول إدغار موران ( .)2014إذا ّ
-روبول ،أوليفييه ( .)1994فلسفة التربية .ترجمة عبد الكبير معروفي .دار توبقال.
-الشرقي ،محمد ( .)2017البيداغوجيا :مفهوم ،تاريخ ومقاربات (دراسة تركيبية) .فضاء آدم. وراء تمرير هذا الموقف أو ذاك ،وهذه األطروحة أو تلك. كان لأليديولوجيا منطق حفظ الهويّة والتماسك خشية
-طوزي ،ميشيل ( .)2018المقاربة بالكفايات في تدؤيس الفلسفة .ترجمة عزالدين الخطابي .مؤمنون بال حدود.
فأي ّ دعوى بالمعنى المنطق ّي ال ب ّد لها من براهين وحجج التناقض والتص ّدع ،أل َّن ذلك يفضي إىل موتها وانهيارها،
- Morin, E. (2014). Introduction à la pensée complexe. Essais. لترسيخها في نفس المستمع .لذلك ،عىل المد ّرس أن يدفع فإ ّن منطق الفلسفة اليوم ال يهاب التناقض أو وجود
المتعلّم إىل التفطّن إىل هذه المهارة في إنشاء التصوّرات المتضا ّدات فيها ،بل إ ّن حملها هذه السمات هو المح ّرك
والمعارف .واأله ّم في هذا السياق أ ّن الحجاج الفلسف ّي كل الرئيس إلبداعيّتها واستمرار يّتها .وبهذا ،فالخوف ّ
محل الضرورة والمطلق.محل الممكن واالحتمال ،ال ّ ّ الخوف من أن تتحوّل الفلسفة إىل أيديولوجيا.
خريف 2020 61 خريف 2020 60
You might also like
- الفلسفة الاسلاميةDocument35 pagesالفلسفة الاسلاميةمحمد الشرفات0% (1)
- - محاضرات الأصول الفلسفية للتربية 1Document367 pages- محاضرات الأصول الفلسفية للتربية 1Kha Zahran100% (1)
- ملخص مقرر مناهج التعليم الابتدائيDocument35 pagesملخص مقرر مناهج التعليم الابتدائيصلاحالديناشباريNo ratings yet
- (5) مناهج دراسية - أسسDocument10 pages(5) مناهج دراسية - أسسRehab AbdellatifNo ratings yet
- فلسفة التربية - مفهومها وواقعها في البلاد العربيةDocument19 pagesفلسفة التربية - مفهومها وواقعها في البلاد العربيةkarimallal93No ratings yet
- اسس بناء المنهج الدراسىDocument8 pagesاسس بناء المنهج الدراسىkhazri.abderrahimooo9No ratings yet
- تلاميد الجدع المشترك لمادة الفلسفة دراسة ميدانيةبالثانوية التأهيلية ادريس الأول بالقنيطرةDocument41 pagesتلاميد الجدع المشترك لمادة الفلسفة دراسة ميدانيةبالثانوية التأهيلية ادريس الأول بالقنيطرةi.mzardNo ratings yet
- تاريخ ونشأة علوم التربيةDocument15 pagesتاريخ ونشأة علوم التربيةAY Oub ffNo ratings yet
- 0 BityDocument5 pages0 BitylaaliliNo ratings yet
- تقرير تربصDocument13 pagesتقرير تربصالأستاذ عبد الحق لزغمNo ratings yet
- مقترح بتصنيف جديد لعلوم التربية، للتعميم والنشرDocument4 pagesمقترح بتصنيف جديد لعلوم التربية، للتعميم والنشرJahaNo ratings yet
- Mem Metodph TalbDocument4 pagesMem Metodph TalbKhalid TagmaNo ratings yet
- Pubdoc 1 10550 1145Document3 pagesPubdoc 1 10550 1145miriwafa512No ratings yet
- Kribar LaghougiDocument83 pagesKribar LaghougiFatiha saadiNo ratings yet
- الوضعية المشكلDocument12 pagesالوضعية المشكلTaïeb Jlassi86% (7)
- تعريف علوم التربيةDocument3 pagesتعريف علوم التربيةTarik Er-rajiNo ratings yet
- أساليب التدريس عند اليونانDocument12 pagesأساليب التدريس عند اليونانBouba S.aNo ratings yet
- المحاضرة الأولى.التعليميةDocument5 pagesالمحاضرة الأولى.التعليميةAymen BenkerriNo ratings yet
- 136758Document40 pages136758Salwa BajganaNo ratings yet
- مسارات الدرس الفلسفي عز الدين الخطابيDocument3 pagesمسارات الدرس الفلسفي عز الدين الخطابيsebai lakhdar50% (4)
- استخدام التمرين في تعليم الفلسفة -نماذج - هشام شحرورDocument15 pagesاستخدام التمرين في تعليم الفلسفة -نماذج - هشام شحرورTercha SophosNo ratings yet
- ﮫﯾﺑرﺗﻠﻟ ﮫﯾﻔﺳﻠﻔﻟا لوﺻﻻا لوﻻا لﺻﻔﻟا ﮫﯾﺎﻋرﺑ Mohamed Ali clay 😎Document9 pagesﮫﯾﺑرﺗﻠﻟ ﮫﯾﻔﺳﻠﻔﻟا لوﺻﻻا لوﻻا لﺻﻔﻟا ﮫﯾﺎﻋرﺑ Mohamed Ali clay 😎mohamed solimanNo ratings yet
- تعليمية الفلسفة- ليسانس3Document7 pagesتعليمية الفلسفة- ليسانس3assia11121996No ratings yet
- Methode EnseignementDocument44 pagesMethode EnseignementOussama SouidNo ratings yet
- 1711803251Document38 pages1711803251bettachehajar44No ratings yet
- الفلسفــة والديداكتيــكاDocument6 pagesالفلسفــة والديداكتيــكاsebai lakhdarNo ratings yet
- Rhetorical Lesson in Light of The Textual Approach An Orthodontic StudyDocument14 pagesRhetorical Lesson in Light of The Textual Approach An Orthodontic StudyomarNo ratings yet
- Copy of الأصول الفلسفيةDocument49 pagesCopy of الأصول الفلسفيةأ-أحمدمحمدىNo ratings yet
- فلسفة التربية عند جون ديوي Philosophie de l' Éducation Shez John DeweyDocument17 pagesفلسفة التربية عند جون ديوي Philosophie de l' Éducation Shez John DeweyCulture PatrimoineNo ratings yet
- علوم التربيةDocument17 pagesعلوم التربيةFadoua LemkhanatNo ratings yet
- Type HereDocument146 pagesType Here2dnhfvcq75No ratings yet
- علوم التربية-الجزء الأولDocument14 pagesعلوم التربية-الجزء الأولrabab ouerdighiNo ratings yet
- DidactiqueDocument7 pagesDidactiquefreuddg2 freudNo ratings yet
- 654287922 علوم التربيةDocument17 pages654287922 علوم التربيةouadila77No ratings yet
- JeuxDocument19 pagesJeuxtarikmlilasNo ratings yet
- ألأسس والمرتكزات النظرية والبيداغوجية للمقاربة بالكفاياتDocument87 pagesألأسس والمرتكزات النظرية والبيداغوجية للمقاربة بالكفاياتi.mzardNo ratings yet
- 1) ايجوغاديبلا (la pédagogie)Document3 pages1) ايجوغاديبلا (la pédagogie)محمد أمحدوكNo ratings yet
- ملخص حلو النمااااااذجDocument7 pagesملخص حلو النمااااااذجsssNo ratings yet
- الأساس المعرفي للمنهج الدراسيDocument7 pagesالأساس المعرفي للمنهج الدراسيAlfi MNo ratings yet
- Didactique Ed ArtistiqueDocument49 pagesDidactique Ed Artistiqueعبداللهبنزنو100% (2)
- فيلوكلوب دليل تربوي لتدريس مادة الفلسفة-أكتوبر2020Document167 pagesفيلوكلوب دليل تربوي لتدريس مادة الفلسفة-أكتوبر2020Med yahya BensalahNo ratings yet
- Code: LAEE 251Document20 pagesCode: LAEE 251Nour BenhamidaNo ratings yet
- عرض مفهوم مادة التربية الإسلاميةDocument16 pagesعرض مفهوم مادة التربية الإسلاميةمحمد صبحيNo ratings yet
- 9 2019 03 22!11 36 01 PMDocument3 pages9 2019 03 22!11 36 01 PMosama112010No ratings yet
- محاضرات سوسيولوجيا التربيةDocument24 pagesمحاضرات سوسيولوجيا التربيةEmane RahmouniNo ratings yet
- C 0 F 6Document3 pagesC 0 F 6anouarlabbihi7No ratings yet
- التّصورات البديلة حواجز إبستيمولوجية تعيق تعلّم التّلاميذ إذا ما تم تجاهلهاDocument36 pagesالتّصورات البديلة حواجز إبستيمولوجية تعيق تعلّم التّلاميذ إذا ما تم تجاهلهاMejdoline MejdiNo ratings yet
- علوم التربيّة 95Document58 pagesعلوم التربيّة 95Abdelbast El HadiNo ratings yet
- علوم التربيّةDocument58 pagesعلوم التربيّةAmeur BaguaNo ratings yet
- فلسفة التربية والتربية البدنيةDocument8 pagesفلسفة التربية والتربية البدنيةRamsis SphinxNo ratings yet
- VELSSEVADocument336 pagesVELSSEVAIves SonNo ratings yet
- محور التربيةDocument22 pagesمحور التربيةKaoutar ERRGOUAINo ratings yet
- الوثسقة المرافقة فلسفة 2 ثانوي مدونة الحسامDocument24 pagesالوثسقة المرافقة فلسفة 2 ثانوي مدونة الحسامTimou ChaNo ratings yet
- مدخل إلى التربيةDocument12 pagesمدخل إلى التربيةraadNo ratings yet
- Eprint 3 5674 399Document2 pagesEprint 3 5674 399hihoassmaeNo ratings yet
- المراقبة المستمرة في مادة الفلسفة بالجذوع المشتركة والسنة الأولى من سلك البكالورياDocument7 pagesالمراقبة المستمرة في مادة الفلسفة بالجذوع المشتركة والسنة الأولى من سلك البكالورياsaid imaniNo ratings yet
- النظريات التربوية المعاصرةDocument33 pagesالنظريات التربوية المعاصرةأحمد غزالNo ratings yet
- الجذاذة العامة لمحور محطات من تاريخ الفلسفة - CopieDocument4 pagesالجذاذة العامة لمحور محطات من تاريخ الفلسفة - Copienaaim taoufikkNo ratings yet