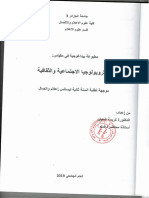Professional Documents
Culture Documents
اتجاهات دراسة الأنثروبولوجيا وفروعها
اتجاهات دراسة الأنثروبولوجيا وفروعها
Uploaded by
hameni kaid0 ratings0% found this document useful (0 votes)
10 views13 pagesاتجاهات دراسة الأنثروبولوجيا وفروعها
Copyright
© © All Rights Reserved
Available Formats
DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this Documentاتجاهات دراسة الأنثروبولوجيا وفروعها
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
10 views13 pagesاتجاهات دراسة الأنثروبولوجيا وفروعها
اتجاهات دراسة الأنثروبولوجيا وفروعها
Uploaded by
hameni kaidاتجاهات دراسة الأنثروبولوجيا وفروعها
Copyright:
© All Rights Reserved
Available Formats
Download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 13
اتجاهات دراسة األنثروبولوجيا وفروعها ************:
الفصل األّو ل -دراسة األنثروبولوجيا واتجاهاتها المعاصرة
أوًال-بداية دراسة األنثروبولوجيا
ثانيًا-االتجاهات المعاصرة في دراسة األنثروبولوجيا
الفصل الثاني -األنثروبولوجيا الطبيعّية
الفصل الثالث -األنثروبولوجيا النفسّية
الفصل الرابع -األنثروبولوجيا الثقافية
الفصل الخامس -األنثروبولوجيا االجتماعية
الفصل السادس -المنهج األنثروبولوجي والدراسات الميدانّية
الفصل األّو ل
دراسة األنثروبولوجيا واتجاهاتها المعاصرة
أوًال -بداية دراسة األنثروبولوجيا
ثانيًا -االتجاهات المعاصرة لدراسة األنثروبولوجيا
-1االتجاه التاريخي
-1/1االتجاه التاريخي /التجزيئي
-1/2االتجاه التاريخي /النفسي
-2االتجاه البنائي /الوظيفي
مقــّد مـة
لم تعرف األنثروبولوجيا قبل النصف الثاني من القرن العشرين ،تقسيمات وفروعًا ،إذ كانت
تتّم ألغراض خاصة بالباحث أو من يكّلفه ،كدراسة حياة بعض المجتمعات أو مكوناتها
الثقافية .
ومع انطالقتها في الستينات والسبعينات من القرن العشرين ،حيث أخذت تتبلور مبادئها
وأهدافها ،كانت ثّم ة محاوالت جاّد ة لتوصيفها كعلم خاص ،وبالتالي وضع تقسيمات لها
وفروع من أجل تحقيق المنهجية التطبيقية من جهة ،والشمولية البحثية التكاملية من جهة
أخرى .فظهرت نتيجة ذلك تصنيفات متعّد دة ،استند بعضها إلى طبيعة الدراسة ومنطلقاتها،
بينما استند بعضها اآلخر إلى أهدافها .
فقد قّسمها /رالف بدنجتون /في كتابه " مقّد مة في األنثربولوجيا االجتماعية " الصادر عام
، 1960إلى قسمين أساسيين ( :األنثربولوجيا العضوية أو الطبيعية ،واألنثروبولوجيا
الثقافية ).
أّم ا /بارنو /فقد قّسمها في كتابه " األنثروبولوجيا الثقافية " الصادر عام ،1972إلى ثالثة
أقسام ،هي ( :األنثروبولوجيا التطبيقية ،األنثربولوجيا النفسية أو الثقافة والشخصية،
األنثروبولوجيا االجتماعية ).
ًا
وإذا اعتبرنا أّن االنثروبولوجيا التطبيقية ،هي أقرب إلى المنهج البحثي وليست فرع من علم
األنثروبولوجيا ،ومن ثّم قمنا بعملية توليف بين األقسام األخرى في التصنيفين السابقين،
أمكننا الوصول إلى التصنيف التالي الذي يضّم أربعة فروع (أقسام) رئيسة تشمل الجوانب
المتعّلقة باإلنسان /الفرد والمجتمع ،/وهي ( :األنثروبولوجيا العضوية /الطبيعية ،
األنثربولوجيا النفسّية ،األنثروبوبوجيا الثقافية ،األنثروبولوجيا االجتماعية ) .وسنتعّرف فيما
يلي كّل فرع من هذه الفروع .
أوًال-البدايات األولى لدراسة األنثروبولوجيا :
شهد القرن العشرين مراحل تكوين األنثروبولوجيا وتطويرها ،لتصبح كيانًا أكاديميًا ومهنة
متخّص صة عند كثير من العلماء والفالسفة والباحثين .فعلى الرغم من أّن الفكر
األنثروبولوجي قد ظّل خالل العقدين األوليين من القرن العشرين ،متأّثرًا إلى حّد بعيد،
بالنظريات التي سادت وتبلورت في السنوات األخيرة من القرن التاسع عشر ،فإّنه سرعان ما
تغّير وتحّو ل إلى منطلقات جديدة ،نتج عنها اّتجاهات متعّد دة إزاء دراسة اإلنسان وحضارته،
سواء ما كان منها نظريًا أو منهجّيًا (فهيم ،1986 ،ص )149
إّن االتجاه العلمي الذي نشط في القرن التاسع عشر ،وتبلور في مجاالت متعّد دة ،دفع العقل
اإلنساني إلى نبذ الفكر الفلسفي الذي كان يتحّفظ على قدرة العقل اإلنساني في التوّصل إلى
الحقيقة المطلقة .وهذا ما نتج عنه قيم فكرية جديدة تدعو إلى النظر إلى العقل والمنطق
المحسوس ،والواقع الملموس كأدوات للمعرفة ،كما تدعو إلى التفاؤل بمستقبل اإلنسانية .
إّال أن أحداث الحرب العالمية األولى ونتائجها السلبية على المجتمع اإلنساني ،بّد دت هذا
التفاؤل ،وأحّلت محّله النظرة التشاؤمية .وهذا ما بدا في نظرة الفالسفة إلى مشكالت اإلنسان
في هذا القرن (القرن العشرين ) ،إلى حّد اعتقاد بعضهم أّن المستقبل صعب ومظلم مع
ظهور النازية في ألمانيا ،والفاشية في إيطاليا .وبلغ هذا االّتجاه ذروته فيما عرف
بالحركة( الوجودية) التي شاعت في فرنسا ،وعلى رأسها /جان بول سارتر /الذي عاش ما
بين ()1980 -1905
ّا
وبرز مقابل هذا االتجاه التشاؤمي ،اتجاه آخر اّتصف بالتفاؤل ،كان من أبرز رو ده في
أمريكا الفيلسوف التربوي /جون ديوي /الذي عاش ما بين
( .)1859-1952فقد أصدر كتابه الشهير " إعادة البناء في الفلسفة " وتبّنى فيه موقفًا
صريحًا مناهضًا للفلسفة الميتافيزيقية .
ودعا فيه إلى ضرورة االهتمام بالبحث عن القوى المعنوية التي تحّر ك مناشط اإلنسان،
العتقاد /ديوي /أّن لدى هذا اإلنسان الكثير من اإلمكانات والقدرات التي يمكنه بواسطتها
الخروج من أزمته الراهنة ..كما تساعده في مشكالته الحياتية المتزايدة ،دون اللجوء إلى
قوى خارجة عن نطاق الطبيعة .
وكان للدين أيضًا تأثيراته في تشكيل الفكر األنثروبولوجي في العقود األولى من القرن
العشرين ،وال سّيما على النظم االجتماعية .إّال أّن ذلك التأثير تضاءل أمام تعاظم التيارات
التحّر رية وما رافقها من إنجازات علمية هائلة ،األمر الذي حدا بالكنيسة في بداية النصف
الثاني من القرن العشرين ،إلى تقّبل فكرة الحوار وحرية المناقشة في األمور الدينية والدنيوية
..بعيدًا عن األساليب القمعية التقليدية )Burns,1973,p.892(.
وهكذا ،شّك ل هذا العلم دعامة أساسّية في ثقافة القرن العشرين عامة ،وفي الفكر
األنثربولوجي خاصة ،حيث كان وثيق الصلة بالفكر االجتماعي والقضايا اإلنسانية التي
أسهمت في تحديد موضوعات الدراسات األنثروبولوجية ،ومناهجها وأهدافها .
ثانيًا-االّتجاهات المعاصرة في دراسة األنثروبولوجيا :
القت النظرية التطّو رية التي ظهرت في القرن التاسع عشر ،انتقادات واسعة باعتبارها
استندت إلى الحدس والتخمين ،وتعميم األحكام المطلقة على الثقافات اإلنسانية ،من دون أن
تثبت صّح ة ذلك بالبراهين أو القرائن العملية /الواقعية.
ولذلك ،بدأت تضمحّل تدريجيًا مع بداية القرن العشرين ،لتحّل محّلها أفكار نظرية جديدة
لدراسة الثقافات اإلنسانية ،من حيث نشوؤها ومكّو ناتها وتطّو رها .فكان أن ظهرت خالل
الربع الثاني من القرن العشرين ثالثة اتجاهات رئيسّية متفاعلة فيما بينها ،رّك زت في
دراساتها على تناول العلوم االجتماعية ،بأسسها ومنطلقاتها وأهدافها .وهذا ما أسهم بفاعلية
في إرساء دعائم علم األنثربولوجيا المعاصر .
-1االّتجاه التاريخي :
ويقسم إلى قسمين :االتجاه التاريخي /التجزيئي ،واالّتجاه التاريخي النفسي .وسنقّد م فيما
يلي عرضًا موجزّا لكّل منهما .
-1/1االّتجاه التاريخي /التجزيئي :ذكرنا أّن الفكر التطّو ري للحضارات اإلنسانية ،أصبح
سائدًا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،حيث بدأت تتبلور الدراسات األنثروبولوجية
.وظهر إلى جانبه أيضًا االّتجاه االنتشاري الذي يعتمد على أّن نشأة الحضارة اإلنسانية كّلها
ترجع إلى مصدر (مجتمع) واحد ،ومنه انتشرت إلى أماكن أخرى في العالم .
ويوجد االّتجاه االنتشاري في كّل من األنثروبولوجيا الثقافية واألنثروبولوجيا االجتماعية،
وإن أخذ طابعًا خاّص ّا في كّل منهما .فتطبيق االتجاه االنتشاري في مجال األنثروبولوجيا
الثقافية ،يتعّلق بجمع العناصر الثقافية ،بما في ذلك من العناصر التكنولوجية والفكرية ،بينما
يقتصر في مجال األنثروبولوجيا االجتماعية ،على العالقات والنظم االجتماعية السائدة في
المجتمع ،والتي تشمل بعض العناصر الثقافية ،وال تشملها كّلها .
ويقوم االتجاه هنا على مبدأ هام ،وهو أّن النظم االجتماعية كثيرًا ما تستعار أو تنقل من مكان
إلى مكان آخر .وبناء على ذلك ،فإّن تشابه النظم االجتماعية والعادات ،في المجتمع الواحد أو
في المجتمعات المختلفة ،ال ينشأ على نحو تلقائي ،وإّنما ناتج عن التشابه في اإلمكانات
االجتماعية والطبيعّية واإلنسانية( .جابر ،1991 ،ص ) 85
وعلى الرغم من ذلك ،استمّر اهتمام الباحثين باستخدام المنهج التاريخي في تفسير ظاهرة
التباين بين الحضارات في المجتمعات اإلنسانية .واعتمد هذا االّتجاه على مبدأين اثنين .
أولهما :أّن االّتصال بين الشعوب المختلفة ،كان بفعل االحتكاك الثقافي /الحضاري ،المباشر
وغير المباشر.
وثانيهما :عملية انتشار بعض المكّو نات (الخصائص) الحضارية أو كّلها ،من مصادرها
األصلية إلى المجتمعات األخرى ،سواء بالرحالت التجارية أو بالكشوف أو بالحروب
واالستعمار .وهذان المبدآن متكامالن في دراسة الظواهر الثقافية ،ويمكن من خاللهما تفسير
التباين الحضاري بين الشعوب .
وقد اعتمد هذا االّتجاه منهجًا تاريخيًا –جغرافيًا ،قاده األلماني /فريدريك راتزال /الذي رّك ز
على أهمّية االّتصاالت والعالقات الثقافية بين الشعوب المختلفة ،ودورها في نمو الحضارة
الخاصة والعامة .وتبعه في ذلك تالمذته ،وال سّيما /هوينريخ شورتز /الذي أبرز فكرة وجود
عالقات حضارية بين العالم القديم (إندونيسيا وماليزيا) والعالم الجديد (أمريكا) .وكذلك
/ليوفرو بينيوس /صاحب نظرية (االنتشار الحضاري) بين إندونيسيا وأفريقيا.
وانطالقًا من هذا االّتجاه ،ظهرت في أوروبا نظريتان مختلفتان حول التفسير االنتشاري
لعناصر الثقافة.
النظرية األولى :هي النظرية االنتشارية التي تعتمد األصل المركزي الواحد للثقافة /
الحضارة .سادت هذه النظرية في إنكلترا ،وأرجعت نشأة الحضارة اإلنسانية كّلها إلى
مصدر واحد ،ومنه انتشرت إلى المجتمعات اإلنسانية األخرى .
وكان من رّو اد هذه النظرية ،عالم التشريح /إليوت سميث /وتلميذه /وليم بيري /اللذان رأيا
أّن الحضارة اإلنسانية ،نشأت وازدهرت على ضفاف النيل في مصر القديمة ،منذ حوالي
خمسة آالف سنة قبل الميالد .
وعندما توافرت الظروف المناسبة للتواصل بين الجماعات البشرية ،بدأت بعض مظاهر تلك
الحضارة المصرية القديمة تنتقل إلى أرجاء متعّد دة من العالم ،حيث عجزت شعوبها عن
التقّد م الثقافي واالبتكار الحضاري ،فراحت تعّو ض عن ذلك العجز باالستيراد والتقليد.
(رياض ،1974 ،ص )127
لقد نال /إليوت سميث /شهرة كبيرة عن جدارة ،نتيجة أبحاثه عن المخ ودراساته في
األنثروبولوجية القديمة ،))Paleo-anthropologyحيث انكّب في إحدى فترات حياته على
دراسة المخ في المومياء المصرية .وقادته أبحاثه هذه إلى اإلقامة في مصر ،حيث أدهشته
الحضارة المصرية القديمة .وأخذ ،كما فعل العديدون ،يالحظ أّن الثقافة المصرية القديمة،
تضّم عناصر كثيرة يبدو أّن لها ما يوازيها في ثقافات بقاع أخرى من العالم ،وقلبت نظرياته
الجريئة ،االعتبارات التقليدية عن الزمان والمكان .فلم يقتصر على القول بأّن العناصر
المتشابهة في حوض البحر األبيض المتوسط وأفريقيا والشرق األدنى والهند ،من أصل
مصري ،بل ذهب إلى أّن العناصر المماثلة في ثقافات أندونيسيا واألمريكتين ،تنبع من
المصدر المصري ذاته .
أّم ا /وليم بيري /فقد أعطى في كتابه (أبناء الشمس) شرحا كامًال للنظرية " الهيليوليتية
" Heliolithicوهو االسم الذي أطلق على /المدرسة االنتشارية /عن تاريخ الثقافة.
فعنوان الكتاب ،يشير إلى أحد عناصر المجّم ع الثقافي الذي تزعم هذه المدرسة أّن أصله في
مصر ،ومنها انتشر ..وهو االعتقاد بأّن الملك ابن الشمس ،والعناصر األخرى في هذا
المجّم ع هي :التحنيط ،بناء األهرامات ،والقيمة الكبرى للذهب والآللىء (.هرسكوفيتز،
،1974ص ) 210
وتنطلق براهين /سميث وبيري /من أّن بناء األهرامات أيضًا من منشأ مصري ،كما هي
الحال في أهرامات المكسيك .وكذلك األمر في احتفاظ األفريقيين بعظم ساق الملك المتوّفى،
الستعماله في الطقوس الدينية نتيجة النتشار عادة التحنيط عند المصريين.
النظرية الثانية :هي النظرية االنتشارية التي تعتمد األصل الثقافي /الحضاري ،المتعّد د
المراكز .وكان من دعاة هذه النظرية ،فريق من العلماء األلمان والنمساويين ،وفي طليعتهم /
فريتز جراينور /الذي عاش في الفترة ما بين )1934-1875و/وليم شميدت /الذي عاش
في الفترة ما بين (. )1959-1868
لقد رفض هذا الفريق فكرة المنشأ( المركز) الواحد للحضارة اإلنسانية ،ألّن هذه الفكرة
ضرب من الخيال أكثر من قربها إلى األساس العلمي .وافترضوا وجود مراكز حضارية
أساسية وعديدة ،في أماكن متفرقة في العالم .ونشأ من التقاء هذه الحضارات ،بعضها مع
بعض ،دوائر ثقافية تفاعلت ببعض عمليات االنصهار والتشكيالت المختلفة .
وكان /ويسلر /أّو ل من استعمل (الدائرة الثقافية) بهذا المعنى ،في بحثه عن ثقافات الهنود
األمريكيين .وال يزال تعريفه لهذا المفهوم على الرغم من تعديله ،منذ ذلك الوقت مفيدا في
هذا المجال .يقول /ويسلر " : /إذا أمكننا تجميع سكان العالم الجديد األصليين ،أي الهنود
األمريكيين ،فسنحصل على دوائر متعّد دة :دوائر طعام ،دوائر منسوجات ،ودوائر خزف ...
وغيرها .وإذا أخذنا في الحسبان العناصر جميعها في وقت واحد ،وحّو لنا الوحدات
االجتماعية أو القبلية ،يمكننا أن نجد جماعات محّد دة المعالم ،وهذا ما يعطينا الدوائر الثقافية،
أو تصنيفًا للجماعات وفق عناصر ثقافتهم "( .هرسكوفيتز ،1974 ،ص ) 124
وهذا ما يفّسر أوجه االختالف عن تلك الثقافات المركزية األساسية .إّال أّن أصحاب هذا
الرأي لم يقّد موا الدالئل على أماكن وجود تلك المراكز ،أو عمليات تتبع حركات االّتصال
فيما بينها ،ودراسة النتائج المترّتبة على ذلك ،بطريقة منهجّية سليمة (.فهيم ،1986 ،ص
)160
لقد كانت وجهة نظر المدرسة (الثقافية التاريخية) األلمانية – النمساوية ،أكثر عمقًا وتنميقًا ..
وكانت عنايتها باختيار معايير الحكم على قيمة وقائع االقتباس المفترضة ،وإصراراها على
الحيطة في استخدام مصادر المعلومات ،ودّقتها في تحديد تعريفاتها ،وغنى وثائقها ،تتجاوب
كّلها تمامًا مع متطّلبات البحث العلمي الدقيق ،ولهذا القت قبوًال واسعًا .
تقوم نظرية المدرسة (الثقافية – التاريخية) في جوهرها ،وكما شرحها زعيمها /وليم
شميدت ،/على نظرة صوفية إلى طبيعة الحياة وإلى التجربة اإلنسانية .فقد نشأت هذه
المدرسة ضمن إطار فكري ،واستخدمت تعبيرات ومصطلحات تختلف اختالفًا جوهريًا عن
النظرة العقالنية ،وعن مفردات أغلب المفّك رين األنثروبولوجيين ..ويظهر ذلك في مناقشة /
شميدت /طرائق البحث في دراسة الدوائر الثقافية المختلفة ،والتي تقسم إليها هذه المدرسة،
أي الثقافات جميعها ،.وترى أّنها انتخبت الثقافات الموجودة – اليوم – في العالم ،بواسطة
انتشار عناصرها .
ويعترف /شميدت ،/كما يعترف األنثروبولوجيون جميعهم ،بالحاجة إلى فهم (معنى الحياة
البدائية) بالنسبة لمن يعيشونها .واألهّم من ذلك ،فهم معناها بالنسبة ألولئك الذين عاشوها في
العصور الغابرة ...ويقول /شميدت /إّننا نعرف ذلك باللجوء إلى المبدأ السيكولوجي
التعاطفي ،الذي يستطيع اإلنسان بواسطته أن يضع نفسه في الحالة النفسّية للشخص الذي
يرتبط معه بعالقة ما(.هرسكوفيتز ،1974 ،ص)213
أّم ا إسهام /فريتز جرابنور /في منهج المدرسة التاريخية – الثقافية بوجه خاص ،وفي علم
األنثروبولوجيا ،بوجه عام ،فتمّثل في التحديد الدقيق الموضوعي لمعايير تقييم انتشار بعض
العناصر الثقافية ،من شعب إلى شعب آخر .
فالنظام االجتماعي والثقافة السائدان عند جماعة (مجتمع ما) لهما تأثير انتقائي ،إذ يحوالن
دون قبول نماذج ال تنسجم البّتة مع النسق القائم .وفي الوقت نفسه ،ال يمكن تجاهل أثر
االقتباس على األنظمة االجتماعية ،حيث تتوّقف فرص االقتباس على االحتكاكات التي تكون
وليدة المصادفات .ومثال ذلك :أن تكون الثقافة التي احتّك بها الهنود المكسيكيون هي الثقافة
اإلسبانية ،أمر يمكن اعتباره حدث اتفاقًا وَع َر ضًا .وكذلك الحال بالنسبة لهنود الواليات
المّتحدة األمريكية ،الذين كان معظم احتكاكهم بالثقافتين اإلنجليزية والفرنسّية( .لينتون،
،1964ص ) 354
إّن هذه المعايير التي يدعونها معايير الكيف والكم ،هي أساسية في الدراسات التي تتناول
النقل الثقافي جميعها ،ومعناها بسيط جّد ا ؛ فعندما يبدو للعيان تماثل بين ثقافتي جماعتين
مختلفتين ،فإّن حكمنا حول احتمال اشتقاقهما من مصدر واحد ،يتوّقف على عدد العناصر
المتماثلة ومدى تشابكها .فكّلما ازداد عدد العناصر المتماثلة ،ازداد احتمال وقوع االقتباس ..
وينطبق األمر ذاته على مدى تداخل (تعقيد) عنصر من العناصر .ولذا يمكن استخدام
القصص الشعبية ،مثًال ،استخدامًا مفيدًا في دراسة االحتكاك التاريخي بين الشعوب البدائية.
(هرسكو فيتز ،ص )213
ولم يقتصر التفسير االنتشاري على أوروبا فحسب ،وإّنما امتّد أيضًا إلى أمريكا حيث ظهرت
حركة مماثلة آلراء /سميث وشميدت /من حيث نقد التفسير التطّو ري للثقافة ،واالّتقاق على
فكرة انتشار العناصر الثقافية بطريق االستعارة والتقليد ،كأساس لتفسير التباين الثقافي /
الحضاري بين الشعوب .
أّم ا بخصوص فكرة المراكز الحضارية (الدوائر الثقافية) فيرى أصحاب المدرسة األمريكية،
أّن المالمح المميّز ة لثقافة ما ،وجدت أوًال في مركز ثقافي – جغرافي محّد د ثّم انتقلت إلى
أماكن أخرى من العالم .وهذا يعني أّن أصحاب االّتجاه االنتشاري في أمريكا ،رفضوا آراء
األوربيين بعدم إمكانية التطّو ر الحضاري المستقّل ،وأن بعض الناس بطبيعتهم غير مبتكرين
أو قادرين على القيام بعملية االبتكار والتطّو ر.
وكان األمريكي /فرانز بواز /الرائد األّو ل لهذا االّتجاه التاريخي /التجزيئي ،قد عارض
الفكرة القائلة بوجود طبيعة واحدة وثابتة للتطّو ر الثقافي .ورأى أّن أية ثقافة من الثقافات،
ليست إّال حصيلة نمو تاريخي معّين .ولذلك ،يتوجب على الباحث األنثروبولوجي أن يوّجه
اهتمامه نحو دراسة تاريخ العناصر المكّو نة لكّل ثقافة على حدة ،قبل الوصول إلى تعميمات
بشأن الثقافة اإلنسانية بكاملها .وقد أصّر /بواز /على أّنه لكي تصبح األنثربولوجيا علمًا ،فال
بّد أن تعتمد في تكوين نظرياتها على المشاهدات والحقائق الملموسة ،وليس على التخمينات
أو الفرضيات الحدسّية .
ومن هذا المنطلق ،استخدم /بواز /مصطلح (المناطق الثقافية) لإلشارة إلى مجموعة من
المناطق الجغرافية ذات النمط الثقافي الواحد ،بصرف النظر عّم ا تحتويه هذه المناطق من
جماعات أو شعوب .وقد طّبق /بواز /هذا المفهوم على ثقافات قبائل الهنود الحمر في
أمريكا ،واستطاع تحديد – تمييز -سبع مناطق ثقافية رئيسة ،يندرج تحتها هذا العدد الهائل
من قبائل الهنود الحمر ،والذي كان يزيد عن ( )50قبيلة ،في الوقت الذي نزح األوروبيون
الستعمار القارة األمريكية .
وبهذا يشير مفهوم (المنطقة الثقافية) إلى طرائق السلوك الشائعة بين عدد من المجتمعات التي
تتمّيز باشتراكها في عدد من مظاهر الثقافة ،نتيجة لدرجة معّينة من االّتصال والتفاعل(.أبو
زيد ،1980، ،ص ) 202
وإذا ما تصّفحنا كتابات /بواز /وجدنا أّن أفكاره تتمّيز عن أفكار /سميث وبيري وشميدت /
وغيرهم من االنتشاريين المتطّر فين ،وذلك بتشديده على النقاط التالية :
-1إّن الدراسة الوصفية لالنتشار ،مقّد مة لدراسة عملية االنتشار دراسة تحليلية .
-2يجب أن تكون دراسة االنتشار دراسة استقرائية ،أي أّنه يجب دراسة العناصر الثقافية
المترابطة (المجّم عات الثقافية) التي يزعم أّنها ناشئة عن االنتشار تبعًا لعالقتها الداخلية ،أكثر
من كونها مجموعة من العناصر شّك لها الباحث اعتباطيًا .
-3يجب أن تّتجه دراسة االنتشار من الخاص إلى العام ،ورسم توزيع للعناصر في مناطق
محدودة ،قبل رسم خارطة توّز عها في القارة ،وترك الكالم عن توّز عها في العالم كّله .
-4إّن منهج دراسة العملية الديناميكية ،واالنتشار ليس سوى وجه من وجوهها ،يجب أن
يكون منهجًا سيكولوجيًا ،وأن يعود إلى الفرد بغية فهم حقائق التغّير الثقافي( .هرسكوفيتز،
،1974ص )216
واستنادًا إلى هذه المنطلقات ،يرى /بواز /أّن مراعاة العوامل السيكولوجية الكامنة في عملية
االقتباس ،تكتسب أهمّية كبيرة في هذه الدراسات الثقافية .كما يجب تحليل هذه الثقافات
بصورة إفرادية أوًال ،ومن ثّم إجراء مقارنة تفصيلية فيما بينها ،سواء من حيث نظامها
البنائي أو من حيث عناصرها .وال تكون النتائج مقبولة ،إّال بتحّر يات في مناطق عديدة ـ
تسمح بتعميم هذه النتائج .
فقد اكتشف /بواز /أّن ثّم ة عددًا من السمات الثقافية المشتركة بين جماعات الهنود الحمر،
التي تعيش في السهول الساحلية ألمريكا الشمالية .فعلى الرغم من أّن لكّل منها استقالليتها
الخاصة واسمها ولغتها وثقافتها ،إّال أّن سكانها جميعهم يصطادون الجاموس للغذاء ،ويبنون
المساكن على أعمدة يغطونها بالجلود التي يستخدمونها أيضًا في صنع المالبس.. .
وهكذا جاء مفهوم (مصطلح) المنطقة الثقافية ،كتصنيف وصفي وتحليلي للثقافات ،األمر
الذي يسهل المقارنة بين الثقافات ،ومن ثّم الوصول إلى تعميمات بشأن الثقافة اإلنسانية كّلها .
( أبو زيد ،1980 ،ص )203
ونتج عن هذا االّتجاه االنتشاري بوجه عام ،أن بدأ األنثروبولوجيون ينظرون إلى أّن للثقافات
اإلنسانية كيانات مستقّلة من حيث المنشأ والتطّو ر والمالمح الرئيسة التي تمّيز بعضها من
بعض .وهذا ما عّز ز فكرة تعّد د الثقافات وتنّو عها ،وطرح مفهوم النسبية الثقافية التي
أصبحت من أهّم المفهومات األساسّية في الفكر األنثربولوجي وتطّو ره ،كعلم خاص من
العلوم اإلنسانية لـه منطلقاته وأهدافه ،توجب دراسته من خاللها .
ولكّن نظرية االنتشار الثقافي بحسب فكرة الدوائر المّتحدة المركز ،القت انتقادات شديدة،
ومنها ما وّج هه /إدوارد سابير /الذي ذكر ثالثة تحّفظات على فكرة التوّز ع المستمّر :
أولها :يمكن أن يكون االنتشار في أحد االّتجاهات ،أسرع منه في اّتجاه آخر .
ثانيها :قد يكون الشكل األقدم تاريخيًا ،تعّر ض لتعديالت في المركز ،بحيث يخطىء الباحث
في تحديد المركز الحقيقي ألصل الشكل.
وثالثها :قد يكون لتحّر كات السكان داخل منطقة التوّز ع ،آثار تؤّد ي إلى سوء تأويل نموذج "
االنتشار الثقافي " .
ّل
ولكن ،هل يعني هذا التخ ي عن محاوالت إعادة تركيب االحتكاك التاريخي ،بين الشعوب
البدائية والتطّو ر التاريخي للمناطق التي ليس لها تاريخ؟ والجواب :ليس ثّم ة ما يبّرر هذه
النتيجة .ويبدو أّن هذا الجهد المبذول في هذا المجال ،إذا ما أخذ كل شيء في الحسبان ،جدير
باالهتمام والعناية ،بشرطين :
-1أن يكون باإلمكان اعتبار المنطقة المختارة للتحليل ،ذات وحدة تاريخّية.
-2أن يكون الهدف من التحليل ،تقرير احتمال وقوع التطّو رات التاريخية ،وليس تقرير
الحقيقة المطلقة عنها (.هرسكوفيتز ،1974ص ) 221
ولكن ،مهما تعّد دت األدّلة على ظاهرة االنتشار الثقافي ،فإّنه يتعّذ ر بالنسبة للمجتمعات غير
المتعّلمة –وفي معظم األحيان – التمييز بين العناصر الثقافية التي تسّر بت إليها من الخارج،
وبين العناصر التي نشأت من داخلها .ويّتضح من وجهة النظر التجريبية ،أّن كّل ثقافة
بمفردها اقتبست عن الثقافات األخرى ،أشياء أكثر من التي اخترعتها بذاتها .والدليل على
ذلك ،االنتشار الواسع لعناصر ثقافية معقدة في مجاالت التكنولوجية والفنون الشعبية،
والمعتقدات الدينية والمؤّسسات االجتماعية( .لينتون ،1967 ،ص )272
وهكذا نجد ،أّن عملية االنتشار الثقافي تسير في اّتجاهين ،حيث يستفيد كّل مجتمع من ثقافة
المجتمع اآلخر الذي يحتّك به ..وال سّيما في المجتمعات الكبيرة ،حيث تتّم عملية االنتشار
الثقافي من خالل اقتباس عناصر من ثقافات أخرى ،وانتشار مقّو ماتها وأنماطها الرئيسة
والفرعية ،بين فئات هذه المجموعة البشرية الكبيرة.
-1/2االّتجاه التاريخي /النفسي :
بدأ االّتجاه التاريخي /التجزيئي يتعّد ل ويأخذ مسارات جديدة ،حيث ظهرت فكرة توسيع
المفهوم التاريخي في دراسة الثقافات اإلنسانية ،وذلك بفضل من تأّثروا بنتائج علم النفس،
وال سّيما /سيغموند فرويد /الذي عاش ما بين ( )1939-1852وتالمذته ،الذين رأوا أّنه
باإلمكان فهم الثقافة من خالل التاريخ ،مع االستعانة ببعض مفهومات علم النفس وطرائقه
التحليلية .وهذا ما كان لـه أثر كبير في االّتجاه نحو الكشف عن األنماط المختلفة للثقافات
اإلنسانية.
فقد رأت /روث بيند كيت /ورفاقها أّن دراسة التاريخ ،بوقائعه وأحداثه ،ال تكفي لتفسير
الظواهر االجتماعية والثقافية ،وذلك ألن الظاهرة الثقافية بحّد ذاتها مسألة معّقدة ومتشابكة
العناصر .فهي تجمع بين التجربة الواقعية المكتسبة والتجربة السيكولوجية (النفسية ) ،وأّن
أية سمة من السمات الثقافية ،تضّم مزيجّا من النشاط الثقافي والنفسي بالنسبة لبيئة معّينة .
( أبو زيد،1980 ،
)227
وعلى الرغم من ذلك ،فإّن أية ثقافة ال تؤّلف نظامًا مغلقًا أو قوالب جامدة ،يجب أن تتطابق
معها سلوكات أعضاء المجتمع جميعهم .ويتبّين من حقيقة الثقافة السيكولوجية ،أن الثقافة –
بهذه الصفة – ال تستطيع أن تفعل شيئًا ،ألّنها ليست سوى مجموع سلوكات األشخاص الذين
يؤّلفون مجتمعًا خاصًا (في وقت معين ومكان محّد د) وأنماط عادات التفكير عند هؤالء
األشخاص.
ولكّن ،على الرغم من أّن هؤالء األشخاص يلتزمون – عن طريق التعّلم واالعتياد -بأنماط
الجماعة التي ولدوا فيها ونشأوا ،فإّنهم يختلفون في ردود أفعالهم تجاه المواقف الحياتية التي
يتعّرضون لها معًا .كما أّنهم يختلفون أيضًا في مدى رغبة كّل منهم في التغيير ،إذ إّن
الثقافات جميعها عرضة للتغيير( .هرسكو فيتز ،1974ص)65
وهذا يدّلل على مرونة الثقافة ،وإتاحتها فرصة االختيار ألفرادها ..بحيث أّن القيم التي
يتمّسك بها مجتمع ما وتميزه من المجتمعات األخرى ،ليست كّلها ثابتة بالمطلق وتنتقل إلى
حياة األجيال المتعاقبة ،وإّنما ثّم ة قيم متغّيرة ،تتغّير بحسب التغّيرات االجتماعية والثقافية
التي يمّر بها المجتمع.
ويعتبر كتاب " أنماط الثقافة " الذي نشرته /بيند كيت /عام ،1932البداية الحقيقية لبلورة
االّتجاه التاريخي /النفسي في دراسة الثقافات اإلنسانية .حيث أوضحت الدراسة أّنه من
الضرورة النظرة إلى الثقافات في صورتها اإلجمالية ،أي كما هي في تشكيلها العام .وذلك،
ألّن لكّل ثقافة مركز خاص تتمحور حوله وتشّك ل نموذجًا خاصًا بها ،يميزها عن الثقافات
األخرى .
ومن هذا المنظور ،قامت /بيند كيت /بإجراء دراسة مقارنة بين ثقافات بدائية متعّد دة،
وخلصت إلى أّن ثّم ة عالقات قائمة بين النموذج الثقافي العام ومظاهر الشخصية ،وهذا ما
ينعكس لدى األفراد في تلك المجتمعات .
()F reidle, 1977, p.302
ومن الممكن دراسة مظاهر التكّيف المورفولوجي (الشكلي) للنوع البشري بالمصطلحات
المألوفة في علم األحياء ،وفي الوقت نفسه ،كان ال بّد من تطوير أساليب فنّية جديدة لوصف
مظاهر التكّيف السلوكي والنفسي .ويعّد مفهوم الثقافة من أهم المفهومات التي طّو رت في هذا
المجال ،وأكثرها فائدة وحيوية .ومع أّن هذا المفهوم اقتصر في السابق على النواحي
الوصفية ،فإّنه – على أضعف تقدير – زّو دنا بطريقة محّد دة للتعّر ف إلى النتاج النهائي
لعمليات التكّيف ،فوضع بالتالي أسسًا للمقابلة بين النماذج المختلفة لطرق التكّيف( .لينتون،
،1967ص ) 196
لقد شهد االّتجاه التاريخي /النفسي في الدراسات األنثربولوجية ،ظهورًا متمّيزًا في الربع
الثاني من القرن العشرين ،مترافقًا مع انتشار مدرسة التحليل النفسي التي أنشأها /فرويد /
واستمّد منها األنثروبولوجيون الكثير من المفاهيم النفسية ،لتحديد العالقات المتبادلة بين الفرد
وثقافته في إطار المنظومة الثقافية /االجتماعية.
وقد انصّب اهتمام أصحاب هذا االّتجاه ،على دراسة الموضوعات المتعّلقة بالتمييز الثقافي /
االجتماعي ،باالستناد إلى الميزات النفسية السائدة بين األفراد والجماعات .وتعّد دراسة بيند
كيت ،بعنوان " الكريزنتيموم والسيف ،The Chrsyanthemum and the Swordعام
" 1946من أهّم الدراسات في هذا االّتجاه ،حيث بحثت في عالقة الثقافة بالشخصّية
اليابانية .
وهذا ما ساعد في بلورة السياسة األمريكية تجاه استسالم المحاربين اليابانيين في أثناء
الحرب العالمية الثانية .وأوضحت الدراسة أّن الجنود اليابانيين كانوا سيرفضون االستسالم
بصورة مطلقة ،ويستمرون في القتال حتى الموت .إّال أّن تأثير مبادىء الطاعة والوالء
لإلمبراطور على هؤالء الجنود ،جعلهم يستجيبون لتعليماته ويخضعون ألوامره (.المرجع
السابق ،ص)510
ولكن يرى بعض العلماء _ وهو محّق في ذلك – أّن االنشغال الزائد باألشكال الخارجية
للثقافة ،قد أّثر سلبيًا في المحاوالت الرامية إلى تفّهم داللتها السيكولوجية .ومن المعروف أن
الحقيقة النهائية للثقافة ،هي سيكولوجية ..ونقصد بذلك ،أّن وجود الثقافة يرتبط ارتباطًا وثيقًا
بوجود أناس يديرون مؤّسساتها .وهذه الحقيقة السيكولوجية للثقافة تفّسر االستقرار الثقافي،
أو باألحرى ،تفّسر السبب الذي من أجله تشعر الكائنات البشرية بارتياح كبير عندما تعيش
وفق نظام رتيب معروف .
وهذه الحقيقة تفّسر أيضًا آلية التغّير الثقافي .فاألفراد في كّل مجتمع يملكون قابليات وحوافز
وميوًال ،وقدرات تؤّد ي دورها ضمن إطار القالب الثقافي العام ،وتسهم باستمرار في مراجعة
التقاليد القائمة ،وإدخال تحسينات عليها( .لينتون ،1967 ،ص ) 285
وكان من نتيجة ذلك ،ظهور مدرسة ثقافية نفسية (أمريكية) من روادها ( :كاليد كالكهون،
مرغريت ميد ،رالف لينتون) وغيرهم مّم ن اعتمدوا على مفهوم بناء الشخصّية األساسي
الذي يشير إلى مجموعة الخصائص السيكولوجية والسلوكية ،التي يبدو أّنها تتطابق مع كّل
النظم والعناصر والسمات التي تؤّلف أية ثقافة( .أبو زيد ،1989 ،ص )238إذ إّنه على
الرغم من أّن النمط الثقافي السائد في إي مجتمع ،ال يمكن أن يزيد – أو يقّلل – من وجود
الفوارق الفردية في نطاق الثقافة الواحدة ،إّال أن تلك العالقة القائمة بين األنماط الثقافية
والشخصّية الفردية ،وما تحدث من تأثيرات متبادلة بينهما ،ال يجوز إهمالها ،بل يجب أخذها
في الحسبان أثناء دراسة الثقافات اإلنسانية )Freidle, 1977, p.303(.
إّن األساس السيكولوجي للقوانين االجتماعية القائمة ،مثل ( :أنماط السلوك الثابتة ،واألعراف
والتقاليد ،والعادات والقيم) ،هو تكوين أطر استناد مشتركة ،ناتجة عن احتكاك األفراد
بعضهم ببعض ؛ وإذا ما تكّو نت مثل هذه األطر االستنادية وتغلغلت في أعماق الفرد،
أصبحت عامًال هاّم ًا في تحديد ردود فعله أو تعديلها ،في األوضاع التي سيواجهها فيما بعد،
سواء كانت اجتماعية أو غير اجتماعية ،وال سّيما في الحاالت التي ال يكون الحافز فيها جّيد
التنظيم ،أي في حالة تجربة ليس لها سوابق في السلوك الذي اعتاد عليه الفرد( .هرسكوفيتز،
،1974ص ) 68
وضمن هذا االّتجاه أيضًا ،اهتّم /مالينوفسكي /بنظرية فرويد وكتاباته النفسّية /وعالقة ذلك
بالمحّر مات الجنسّية ،من خالل المادة التي جمعها ميدانيًا من سكان جزيرة (التروبرياند ) .إّال
أّنه عارض تفسير فرويد لعالقة االبن باألم وغيرته من األب في إطار ما أسماه فرويد بـ
(عقدة أوديب ) ،وقّد م بدّال منها تفسيرًا وظيفّيًا ،توّص ل من خالله إلى أّن تحريم العالقات
الجنسية المكّو نة للعائلة الموّح دة (النووية) والتي تشمل " :األم واألبناء واألخوة واألخوات "
هو الذي يمنع ما قد ينشأ من صراعات داخلية ،بسبب الغيرة أو التنافس ..
وهذا ما يحفظ بالتالي تماسك األسرة ،ويمنع تفّك ك أواصرها وتهديم كيانها،
وما ينجم عنه من ضعف المجتمع العام ،وتهديد وحدته وتماسكه.
))Freidle, 1977, p. 303
وخالصة القول ،إّن هذه االّتجاهات بأفكارها وتطبيقاتها ،مّثلت مرحلة انتقالية بين
األنثروبولوجيا الكالسيكية التي كانت تعتمد على التخمينات والتفسيرات النظرية فحسب،
وبين األنثروبولوجيا الحديثة التي بدأت مع النصف الثاني من القرن العشرين معتمدة على
الدراسات الميدانية /التحليلية ،والتي تعنى بالجوانب االجتماعية الثقافية المكّو نة للفكر
األنثروبولوجي.
وهذا ما أّد ى بالتالي إلى ظهور التخّصص في علم األنثروبولوجيا ،مّم ا ساعد في إرساء
المبادىء األساسّية لألنثروبولوجيا المعاصرة .
-2االّتجاه البنائي /الوظيفي :
ترافق نشوء هذا االّتجاه مع ظهور اّتجاه االنتشار الثقافي ،كرّد فعل عنيف على النظرية
التطّو رية .وقد تمّيز االّتجاه البنائي ،بأّنه ليس تطّو ريًا وليس تاريخيًا ،حيث رّك ز على دراسة
الثقافات اإلنسانية كّل على حدة ،في واقعها الحالي /المكاني والزماني ./
وهذا ما جعله يختلف عن الدراسات التاريخّية ،ألّنه اعتمد العلم في دراسة الثقافات اإلنسانية
كظاهرة ،يجب البحث في عناصرها والكشف عن العالقات القائمة فيما بينها ،ومن ثّم
العالقات القائمة فيما بينها وبين الظواهر األخرى( .فهيم ،1986 ،ص )164
يعود الفضل في تبلور االّتجاه البنائي /الوظيفي في الدراسات األنثروبولوجية ،إلى أفكار
العالمين البريطانيين( ،برونسلو مالينوفسكي) و (راد كليف براون ) ،اللذين عاشا في أواخر
القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين .ويدينان باّتجاهاتهما النظرية ،إلى
أفكار عالم االجتماع /إميل دوركهايم /الذي رّك ز اهتمامه على الطريقة التي تعمل بها
المجتمعات اإلنسانية ووظائف نظمها االجتماعية ،وليس على تاريخ تطّو ر هذه المجتمعات
والسمات العامة لثقافاتها.
ولعّل /كلود ليفي ستروس /الوحيد بين البنائيين الفرنسيين ،الذي يستخدم كلمة (بناء أو
بنائية) صراحة في عناوين كتبه ومقاالته ،ابتداء من مقاله الذي كتبه عام ،1945عن "
التحليل البنائي " في اللغويات وفي األنثروبولوجيا ،والذي يعتبر – بحق –" ميثاق " النزعة
البنائية ،وإلى كتاب " األبنية األولية للقرابة " الذي كان سببًا في ذيوع اسمه وشهرته ،والذي
يعتبره الكثيرون أهّم وأفضل إنجاز في األنثروبولوجيا الفرنسية على اإلطالق ..ومن ثّم إلى
كتابه " األنثروبولوجيا البنائية ".
وعلى الرغم من االنتقادات التي وّجهت إليه ،فال يزال يؤمن بأّن البنيوية (البنائية) هي أكثر
المناهج قدرة على تحليل المعلومات وفهم األثنوجرافيا وتقريبها إلى األذهان ،وإّنها في الوقت
نفسه ،أفضل وسيلة يمكن بها تجاوز المعلومات والوقائع العيانية المشّخ صة ،والوصول إلى
الخصائص العامة للعقل اإلنساني .فقد أفلح في أن يحّقق للبنائية ما لم يحّققه غيره ،مع أّنه لم
يقم بدراسات حقلية بين الشعوب المتخّلفة (البدائية ) ،وحتى حين قام بدراساته في (البرازيل
والباكستان) كان يمضي فترات قصيرة ومتباعدة بين الجماعات التي درسها .وخرج بالبنائية
من مجال األنثروبولوجيا ،إلى ميادين الفكر المختلفة ،الواسعة والرحيبة .وجعل منها اتجاهًا
فكريًا ومنهجيًا يهدف إلى الكشف عن العمليات العقلية العامة ،وله تطبيقاته في األدب
والفلسفة واللغة والميثولوجيا (األسطورة) والدين والفن .وبلغ من قّو ة البنائية أن أصبحت في
البداية ،تمّثل تهديدًا مباشرًا للوجودية التي ترّك ز على الفرد والسلوك الفردي( .أبو زيد،
،2001ص ) 83-82
فاالّتجاه البنائي /الوظيفي ،يعّبر في جملته عن منهج دراسي تّم التوّص ل إليه من خالل
المقابلة (الموازنة) بين الجماعات اإلنسانية (المجتمعات) والكائنات البشرية (األفراد ) .ولم
يعد استخدامه مقصورًا على األنثروبولوجيين ،وإّنما تناولـه أيضًا علماء االجتماع بالفحص
والتطبيق والتعديل ،على يد /تلكوت بارسونز ،وجورح ميرتون ./كما ارتبط أيضًا بالعلوم
الطبيعية ،وال سّيما علوم الحياة والكيمياء))Leach, 1982, p.184 .
فقد رأى /مالينوفسكي /أّن األفراد يمكنهم أن ينشئوا ألنفسهم ثقافة خاصة ،أو أسلوبًا معّينًا
للحياة ،يضمن لهم إشباع حاجاتهم األساسية ،البيولوجية والنفسّية واالجتماعية .ولذلك ربط
الثقافة – بجوانبها المختلفة ،المادية والروحية واالجتماعية ،باالحتياجات اإلنسانية .
فاالهتمام بالبنية ،Strutureكترابط منّظم وخفي للعناصر الثقافية ،يساعد النموذج في
تفسيره وراء العالقات االجتماعية ،يوازيه في اتجاه آخر اهتمام وظائفي بالمعنى الذي
يحّد ده /مالينوفسكي ،/والذي تعني فيه الوظيفة :تلبية حاجة من الحاجات ،ويكون فيها
التحليل الوظيفي هو ذلك الذي " :يسمح بتحديد العالقة بين العمل الثقافي والحاجة عند
اإلنسان ،سواء كانت هذه الحاجة أولية أو فرعية /ثانوية " (لبيب ،1987 ،ط ،3ص) 12
فالثقافة كيان كّلي وظيفي متكامل ،يماثل الكائن الحي ،بحيث ال يمكن فهم دور وظيفة أي
عضو فيه ،إّال من خالل معرفة عالقته بأعضاء الجسم األخرى ،وإّن دراسة هذه الوظيفة
بالتالي ،تمّك ن الباحث األثنولوجي من اكتشاف ماهية كل عنصر وضرورته ،في هذا الكيان
المتكامل .
ولذلك ،دعا /مالينوفسكي /إلى دراسة وظيفة كّل عنصر ثقافي ،عن طريق إعادة تكوين
تاريخ نشأته أو انتشاره ،وفي إطار عالقته مع العناصر األخرى .وهذا يقتضي دراسة
الثقافات اإلنسانية كّل على حدة ،وكما هي في وضعها الراهن ،وليس كما كانت أو كيف
تغّيرت .
وبذلك يكون /مالينوفسكي /قد قّد م مفهوم( الوظيفة) كأداة منهجّية تمّك ن الباحث
األنثروبولوجي من إجراء مالحظاته بطريقة مرّك زة ومتكاملة ،في أثناء وصفه للثقافة
البدائية) Freidle, 1977, p.304( .
أّم ا /براون /فقد قام من جهته ،بدور رئيس في تدعيم أسس االّتجاه البنائي /الوظيفي ،في
الدراسات األنثروبولوجية ،وذلك مع بداية القرن العشرين ،موّجهًا األثنولوجيا نحو الدراسات
المتزامنة ،وليس نحو التفسير البيولوجي للثقافة كما فعل /مالينوفسكي . /
اعتمد /براون في دراسة المجتمع وتفسير الظواهر االجتماعية تفسيرًا اجتماعيًا ،بنائيًا
ووظيفيًا ،على فكرة الوظيفية التي نادى بها /دوركهايم /والتي تقوم على دراسة المجتمعات
اإلنسانية ،من خالل المطابقة (المماثلة) بين الحياة االجتماعية والحياة العضوية ،كما هي
الحال في المشابهة بين البناء الجسمي المتكامل عند اإلنسان ،والبناء االجتماعي المتكامل في
المجتمعات اإلنسانية .
ويوضح /براون /طبيعة هذا (البناء االجتماعي) بأّنه يندرج تحت هذا المفهوم ،العالقات
االجتماعية كّلها ،والتي تقوم بين شخص وآخر .كما يدخل في ذلك التمايز القائم بين األفراد
والطبقات ،بحسب أدوارهم االجتماعية ،والعالقات التي تنّظم هذه األدوار .وكما يستمّر تجّد د
بناء الكائن العضوي طوال حياته ،فكذلك تتجّد د الحياة االجتماعية مع استمرارية البناء
االجتماعي في عالقاته وتماسكه .
واستنادًا إلى ذلك ،يصبح االعتراف بالتنّو ع الثقافي بين المجتمعات – مهما كان شكله -إحدى
الخطوات الهامة في تطّو ر علم األنثروبولوجيا ،انطالقًا من النقاط التالية:
-1إّن الثقافة تعبير عن سلوك شعب ما ،وعن قواعد هذا الشعب .
-2إّن مجموع التنّو عات في العقيدة والسلوك الفرديين لدى أفراد جماعة معّينة وفي زمن
معّين ،يحّد د ثقافة تلك الجماعة ..وهذا صحيح بالنسبة للثقافات الفرعية في الوحدات
الصغيرة ،داخل الكّل االجتماعي.
-3ليست العقيدة والسلوك في أي مجتمع ،أبدًا نتاج الصدفة ،بل يتحّو الن وفق قواعد راسخة.
-4يجب استنباط هذه القواعد بواسطة االستقراء من التوافق المالحظ في العقائد وأنماط
السلوك لدى جماعة ما ..وهي تشمل نماذج ثقافة تلك الجماعة .
-5كّلما صغر حجم الجماعة ،كانت نماذج عقائدها وسلوكاتها ،أكثر تجانس فيما إذا تساوت
ًا
األمور األخرى.
-6قد يظهر لدى الفئات االختصاصية ،تنّو ع في حقل اختصاصها أكثر اّتساعًا مّم ا يظهر
لدى الفئات األخرى ،المساوية لها في الحجم ،بين الجماعة الكلّية( .هرسكوفيتز ،1974 ،ص
) 264-263
وإزاء هذه األمور مجتمعة ،ال بّد من االعتراف بأهمّية مسألة التجانس الثقافي والتنافر
الثقافي ،في الدراسات األثنولوجية ،وفي أثناء مناقشة النظريات األنثروبولوجية.
وإذا كان /مالينوفسكي /أخذ بفكرة النظم االجتماعية لتأمين الحاجات البيولوجية والنفسية
لألفراد ،بينما اّتجه /براون /نحو مسألة تماسك النظام االجتماعي ،من حيث مكّو ناته
وعالقاته ،فأّنهما رفضا معًا فكرة تجزئة العناصر الثقافية (مكّو نات البناء االجتماعي) إلى
وحدات صغيرة يقوم الباحث بدراسة منشئها أو انتشارها وتطّو رها ..
واعتمدا بدّال من ذلك على الدراسات الميدانية ،لوصف الثقافات بوضعها الراهن .وقد وجد
هذا االّتجاه قبوًال واسعًا لدى المهتّم ين بدراسة الثقافات اإلنسانية في النصف األّو ل من القرن
العشرين ،وال سّيما بين األنثربولوجيين األوروبيين ،الذين انتشروا في المستعمرات إلجراء
دراسات ميدانية ،وجمع المواد األولية الالزمة لوصف الثقافات في هذه المجتمعات ،وتحليلها
في إطارها الواقعي وكما هي في وضعها الراهن .
**
مصادر الفصل ومراجعه:
-أبو زيد ،أحمد ( )1980البناء االجتماعي – مدخل لدراسة المجتمع ،ج ،1الهيئة المصرية
العامة للكتاب ،القاهرة .
-أبو زيد ( )2001الطريق إلى المعرفة ،كتاب العربي ( ،) 46منشورات مجّلة العربي،
الكويت .
-جابر ،سامية ( )1991علم اإلنسان – مدخل إلى األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية ،دار
العلوم العربية ،بيروت .
-رياض ،محمد ( )1974اإلنسان – دراسة في النوع والحضارة ،دار النهضة العربية،
بيروت .
-فهيم ،حسين ( )1986قصة األنثروبولوجيا – فصول في تاريخ اإلنسان ،عالم المعرفة
( ،) 198الكويت .
-لبيب ،الطاهر ( )1987سوسيولوجيا الثقافة ،دار الحوار ،الالذقية .
-لينتون ،رالف ( )1967األنثروبولوجيا وأزمة العالم الحديث ،ترجمة :عبد الملك الناشف،
المكتبة العصرية ،بيروت .
-هرسكوفيتز ،ميلفيل .ج ( )1974أسس األنثروبولوجيا الثقافية ،ترجمة :رباح النفاخ،
وزارة الثقافة ،دمشق .
. Burns , Edward (1973) Western Civizalition , New York -
Freidl ,John (1977) Anthropology , HarperandRowPublishers, New -
. York
Leach , Edmund, (1982) Social Anthropology , Font and -
. Paperbacks -
: Toutes les réactions
1010
You might also like
- الحداثة وما بعد الحداثة (م 5Document34 pagesالحداثة وما بعد الحداثة (م 5Mohammed Ali Abdullah100% (1)
- الفصل الاول الانثروبولوجياDocument4 pagesالفصل الاول الانثروبولوجياMin TotaNo ratings yet
- تعريف النظرية التطوريةDocument13 pagesتعريف النظرية التطوريةPrince Amir100% (1)
- الانثربولوجيا الاجتماعيةDocument5 pagesالانثربولوجيا الاجتماعيةhassan aliNo ratings yet
- ماهية الأنثروبولوجياDocument15 pagesماهية الأنثروبولوجيامكتبة الأمانيNo ratings yet
- ملخص محاضرات مدخل الى الانتروبولوجياDocument13 pagesملخص محاضرات مدخل الى الانتروبولوجياnarimanenounou97No ratings yet
- نظرية الحوليات و التاريخ الجديد PDFDocument15 pagesنظرية الحوليات و التاريخ الجديد PDFRania Djaballah50% (2)
- الانثروبولوجيا النفسية PDFDocument7 pagesالانثروبولوجيا النفسية PDFhassan aliNo ratings yet
- المحاضرة الأ ولى مدرسة برمنغهامDocument19 pagesالمحاضرة الأ ولى مدرسة برمنغهامnarimane 2001No ratings yet
- UntitledDocument5 pagesUntitledNessrine KrimiNo ratings yet
- محاضرة رقم 01 انثروبولوجيا اجتماعية و ثقافيةDocument4 pagesمحاضرة رقم 01 انثروبولوجيا اجتماعية و ثقافيةachourichrak7No ratings yet
- 3Document30 pages3hh jjjNo ratings yet
- المطبوعة النهائية مع تصحيح الكتاب في مدخل الى الانثروبولوجياDocument105 pagesالمطبوعة النهائية مع تصحيح الكتاب في مدخل الى الانثروبولوجياDbaKheNo ratings yet
- Anthropologie M126 NVNVDocument11 pagesAnthropologie M126 NVNVmohamed boubechtoulaNo ratings yet
- التطبيقــات الأنثروبولوجيـــةDocument15 pagesالتطبيقــات الأنثروبولوجيـــةMaria YunusNo ratings yet
- 1Document100 pages1sami ghezalNo ratings yet
- بحث الأنثروبولوجياDocument6 pagesبحث الأنثروبولوجياrayanchicharitoNo ratings yet
- انثرولوبوجياDocument10 pagesانثرولوبوجياsalahNo ratings yet
- Cours D'anthropologie 1 LMDDocument25 pagesCours D'anthropologie 1 LMDCherifi Med benNo ratings yet
- تاريخ ومراحل نشأة الانثربولوجياDocument11 pagesتاريخ ومراحل نشأة الانثربولوجيامساعد طلبة التخرجNo ratings yet
- 290السوسيو انثروبولوجياوبناء الموضوع المحليDocument19 pages290السوسيو انثروبولوجياوبناء الموضوع المحليHair Styles100% (2)
- دروس اثنوغرافيا الجمهور والمستخدمين للأستاذ بوزيان نورالدينDocument61 pagesدروس اثنوغرافيا الجمهور والمستخدمين للأستاذ بوزيان نورالدينasuna aoe100% (1)
- الانتروبولوجياDocument35 pagesالانتروبولوجياأحمت السباعيNo ratings yet
- الانتروبولوجية النفسيةDocument2 pagesالانتروبولوجية النفسيةadel460216No ratings yet
- محاضرات مادة الأنثربولوجياDocument23 pagesمحاضرات مادة الأنثربولوجياسعيدبنالعربيNo ratings yet
- الدرسDocument4 pagesالدرسchahrazed.sociologyNo ratings yet
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةDocument10 pagesالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةChaoukiMatimaticNo ratings yet
- الانثربولوجياDocument12 pagesالانثربولوجياabdelghani cherifiNo ratings yet
- الأنتروبولجيا 2Document15 pagesالأنتروبولجيا 2لمينNo ratings yet
- Houda PDFDocument17 pagesHouda PDFchaimadjemmahNo ratings yet
- اتجاهات معاصرة في الأنثروبولوجياDocument12 pagesاتجاهات معاصرة في الأنثروبولوجياSumaea AyadNo ratings yet
- تطبيقات الأنثروبولوجيا قبل نشأةDocument13 pagesتطبيقات الأنثروبولوجيا قبل نشأةلمين100% (1)
- خطة البحـــثDocument4 pagesخطة البحـــثBouba S.aNo ratings yet
- - اساسيات الاجتماع والاجتماع الريفىDocument131 pages- اساسيات الاجتماع والاجتماع الريفىamr saad ahmad aliNo ratings yet
- - - مدخل إلى علم الإنسان - (الأنثروبولوجيا) - عيسى الشماس - مكتبة التنوير PDFDocument248 pages- - مدخل إلى علم الإنسان - (الأنثروبولوجيا) - عيسى الشماس - مكتبة التنوير PDFSelouayakhelefNo ratings yet
- Amzighe AntrhopologieDocument16 pagesAmzighe AntrhopologieⴰⵖⵡⴰⵖNo ratings yet
- التاريخ والانثروبولوجياDocument3 pagesالتاريخ والانثروبولوجياŚặł Ặĥ ßŏukĥíặřNo ratings yet
- مدخل لعلم الاجتماع معبود -Document21 pagesمدخل لعلم الاجتماع معبود -حملاوي مفتاح0% (1)
- الانثروبولوجيا النفسية PDFDocument7 pagesالانثروبولوجيا النفسية PDFkolmandoro100% (3)
- الانثروبولوجيا النفسية PDFDocument7 pagesالانثروبولوجيا النفسية PDFkolmandoroNo ratings yet
- الجواب الأولDocument2 pagesالجواب الأولcyber Star NetNo ratings yet
- بحث حول الانثروبولوجياDocument9 pagesبحث حول الانثروبولوجياroufeyda der100% (1)
- المحاضرة الأولىDocument6 pagesالمحاضرة الأولىwassimbba2002No ratings yet
- المحاضرة الأولىDocument4 pagesالمحاضرة الأولىhaitemzain1No ratings yet
- الاستاذة حفحوف فتيحة- مقياس الانثروبولوجياDocument37 pagesالاستاذة حفحوف فتيحة- مقياس الانثروبولوجياLamar LunaNo ratings yet
- الحداثة وما بعد الحداثة (م 5Document38 pagesالحداثة وما بعد الحداثة (م 5slmnfskyaswdyantmNo ratings yet
- تطبيقات الأنثروبولوجيا قبل نشأةDocument14 pagesتطبيقات الأنثروبولوجيا قبل نشأةلمين100% (4)
- المقاربة الوظيفيةDocument7 pagesالمقاربة الوظيفيةguerfakhalil59No ratings yet
- اسس علم الاجتماع 6 - مجموعة 3 و4Document11 pagesاسس علم الاجتماع 6 - مجموعة 3 و4Abd'salam LazNo ratings yet
- Article 7 N7Document17 pagesArticle 7 N7DIOUCHE KAMELNo ratings yet
- الجزء الثالث نسخة2Document11 pagesالجزء الثالث نسخة2Samar MNo ratings yet
- E. TylorDocument7 pagesE. Tylorkrks24No ratings yet
- DocDocument23 pagesDocBck MeydiNo ratings yet
- PolycopeDocument115 pagesPolycopeMounir BelhadNo ratings yet
- عربي شهوانDocument6 pagesعربي شهوانyr44grf94kNo ratings yet
- Sociologie de L ImmigrationDocument6 pagesSociologie de L ImmigrationYouness NounousNo ratings yet
- 8 2021 05 03!01 06 57 PMDocument43 pages8 2021 05 03!01 06 57 PMyounseabousaid880No ratings yet
- المحاضرة الثانيةDocument3 pagesالمحاضرة الثانيةhadjer amel Dehini100% (1)
- Ø Ù Ø Ù Ø Ø Ù Ø Ù Ù Ù Ø Ù Ø M1Document4 pagesØ Ù Ø Ù Ø Ø Ù Ø Ù Ù Ù Ø Ù Ø M1Saif GhorriNo ratings yet
- مستويات التشريحDocument4 pagesمستويات التشريحhameni kaidNo ratings yet
- مدخل إلى علم السكانDocument10 pagesمدخل إلى علم السكانhameni kaidNo ratings yet
- مدخل عام إلى الفلسفة المسيحية في العصور الوسطىDocument8 pagesمدخل عام إلى الفلسفة المسيحية في العصور الوسطىhameni kaidNo ratings yet
- الانثروبولوجيا في الوطن العربيDocument14 pagesالانثروبولوجيا في الوطن العربيhameni kaidNo ratings yet
- علاقة الفلسفة بالعلمDocument3 pagesعلاقة الفلسفة بالعلمhameni kaidNo ratings yet